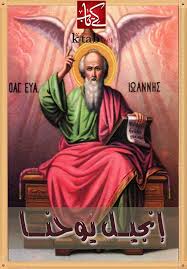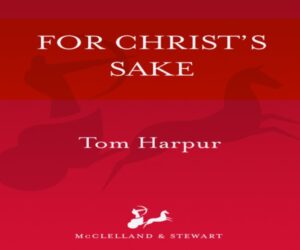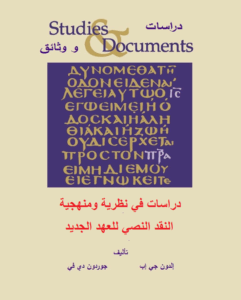إشكالات حول إنجيل يوحنا
مقدمة تفسير إنجيل يوحنا
تأليف: برنابا ليندرز
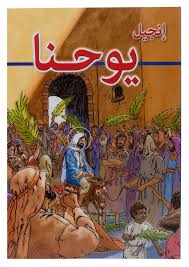
مقدمة المترجمين
طالما سبب الإنجيل الرابع (إنجيل يوحنا) اختلافًا وجدالًا كثيرًا في الأوساط العلمية المسيحية لاختلافه عن الأناجيل الإزائية الثلاثة من حيث الشكل والمضمون. بداية فإن شخص المؤلف غير معروف على وجه اليقين وكذلك زمن الكتابة وأين تم التأليف… كما سنرى.
ومن حيث اللغة فقد اتصفت بمحدودية المفردات واحتوى على بعض الإشكالات في أدوات الربط والعطف والإشارة والضمائر وكذلك أزمنة الأفعال مما يدل على عدم تمكن المؤلف من اللغة اليونانية بشكل تام. يقول مؤلف التفسير يبدو من المرجح أن اليونانية لم تكن لغة يوحنا الأولى، وأنه تعلمها متأخرًا جدًا بحيث لم يُسمح له بإتقانها تمامًا. كما شاب مقاطعه التفكك والانتقالات المفاجئة والتشوهات وارتباك الترتيب مما يوحي أنه تم تفكيكة وإعادة تركيب أجزائه مع اختلاف تسلسل أحداثه وتفاصيلها عن الأناجيل الإزائية. ويعزى ذلك إلى اعتماد المؤلف على مصادر غير إزائية وأخرى شفوية بجانب مواد الأناجيل الإزائية.
ويلاحظ أن الإنجيل تم تجميعه على مراحل في أكثر من طبعة بواسطة مؤلف الإنجيل أو بعض المحررين الكنسيين مع إضافة مواد تكميلية كالمقدمة (يو1: 1-18) الموزونة شعريا والفصل الحادي والعشرين.
ومن حيث اللاهوت فقد جاء الإنجيل الرابع بمفهوم الكلمة اللوجوس المستمد من مفهوم العقل الكلي في الفكر اليوناني الهيلنستي وفلسفة الفيلسوف اليهودي فيلو الذي عاش في النصف الثاني من القرن الأول وعاصر بولس. وركز هذا الإنجيل على شخصية يسوع كمخلص وعلاقته بالله وعلى الصلب والفداء بينما ركزت الأناجيل الإزائية على ملكوت الله والتوبة وحفظ الوصايا.
إن النهج الخيالي في وصف الشخصيات، المتمثل في شخصية التلميذ الحبيب، يحذرنا من المبالغة في تصديق التفاصيل الظرفية العديدة الواردة في هذا الإنجيل. من ناحية أخرى (كما يقول مؤلف التفسير)، لا يزال بإمكاننا الاعتقاد بأن مؤلف الإنجيل اعتمد على مصادر ممتازة. علاوة على ذلك، يمكننا معرفة المزيد عنه من خلال دراسة خلفية فكره.
ومن الناحية التاريخية لا شك أن الملاحظات المذكورة ستُثير بعض الشك حول قيمة الإنجيل الرابع كوثيقة تاريخية. فسوف نرى فيما سيعرضه مؤلف التفسير أن يوحنا لا يُمكن اعتباره شاهد عيان على الأحداث التي سجّلها، وأنه يكتب بعد وقوعها بوقت طويل. على أي حال، فإن عرضه لها يهيمن عليه هدفه اللاهوتي.
تفاصيل كل ذلك وغيره من المسائل سوف نقرؤه في هذه المقدمة التي كتبها العلامة القس باربارا ليندرز في بداية تفسيره القيم الشامل لإنجيل يوحنا طبقا للطبعة القياسية المنقحة (Revised Standard Version).
1. الرسالة المركزية للإنجيل الرابع
إنجيل يوحنا كتابٌ يحمل رسالة. يريد مؤلف الإنجيل أن يوصل القارئ إلى نقطة اتخاذ القرار. وكما يقول في 20: 30 وما يليها (الخاتمة الأصلية للكتاب)، فقد قام بعمله “لكي تؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه”. ويتجلى هدفه بوضوح مماثل في “الإنجيل المصغر” في 3: 16: “لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكيلا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية”. وهذا ليس بيانًا غامضًا. فهو يقدم احتمالين: “الهلاك”، أو “الحصول على الحياة الأبدية”. ولا يعرف يوحنا أي طريق وسط. فهو يرى البشرية تواجه حتمًا هذين البديلين المهيمنين. فالإنسان متورط في صراع على السلطة بين القوى الكونية. فمن جهة، تقف الظلمة (والتي غالبًا ما تُعبّر عنها بعبارات أخرى: “العمى”، “الشر”، “هذا العالم”، “أمير هذا العالم”)؛ هذا يؤدي إلى الهلاك والموت. على الجانب الآخر، هناك النور (المرتبط بالبصر، والروح، و”ماء الحياة”، و”خبز الحياة”، و”نور العالم”، والشركة مع الله)؛ وهذا يؤدي إلى الخلاص والحياة في العصر الجديد. وبالتالي، فإن الاختيار بين النور والظلمة يؤثر على وجود الإنسان بأكمله.
يؤمن يوحنا إيمانًا راسخًا أن العامل الحاسم في هذا القرار هو موقف المرء من يسوع المسيح. ذلك أن ظهور يسوع على صعيد التاريخ هو انبثاق النور من العالم الإلهي في النظام المخلوق، حيث يستشري الشر. وهكذا يُخاض صراع السلطة، ليس فقط على المستوى الكوني، بل أيضًا في الأحداث التاريخية لحياة يسوع. وفي هذا الصراع، يكون الصليب محوريًا. إنها “الساعة” (١٢: ٢٣؛ ١٣: ٣١) التي يبدو فيها أن قوى الظلام قد أسقطت عدوها. لكن يوحنا، بسخرية رائعة، يُظهر أن الظلام هو الذي يُهزم، وأن النصر يُحرز في الصليب (٣: ١٤؛ ٨: ٢٨؛ ١٢: ٣٤). بالإيمان بيسوع، يمكن للناس أن يشاركوه في نصره؛ ويعني هذا، بالنسبة ليوحنا، تسليم الذات ليسوع بالتزام شخصي كامل؛ فلا ينجو الإنسان بذلك من نصيبه في الصراع (١٥: ٢٠)، بل إن نصره مضمون (١٦: ٣٣).
قد يجد القارئ المعاصر صعوبة في فهم النظرة العالمية المفترضة هنا. لكنه بقراءة الإنجيل سيجد مرارًا وتكرارًا أنها تمس أعماق الوجود البشري. ولا تزال أهمية الرسالة ملحة.
2. يوحنا والأناجيل الإزائية
إذا كان هدف يوحنا عمليًا في المقام الأول بهذه الطريقة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا اختار صيغة الإنجيل. نميل إلى اعتبار الأناجيل سيرةً ذاتية ليسوع، ولكن لا يُنظر إلى أيٍّ منها على أنه كذلك بحق.1
(أ) تشير كلمة إنجيليون (evangelion) اليونانية إلى إعلان ( كيريغما kërygma) البشارة (مرقس 1: 15). وهي مشتقة من كلمة إنجيليزو (evangelizō)، المستخدمة في الترجمة السبعينية لإشعياء 52: 7 لترجمة الكلمة العبرية بيسير bisśēr (= جلب البشارة). وبالتالي، فهي تشير إلى نشاط الوعظ (راجع 1 كو 1: 21). وقد أكدت أقدم العظات أن النبوءات قد تحققت وأن العصر الجديد قد بدأ بمجيء المسيح: فقد وُلد من نسل داود، ومات وفقًا للكتاب المقدس ليخلصنا من هذا العالم الشرير، ودُفن، وقام في اليوم الثالث وفقًا للكتاب المقدس، ورُفع إلى يمين الله. “وسوف يأتي مرة أخرى كقاضٍ ومخلص للبشرية “.2 وهنا يمكننا أن نرى بالفعل إطار الأناجيل، والتي يمكن أن نسميها عبارات تبشيرية مليئة بالمواد السيرية.
(ب) كانت المواد السيرية جاهزة، إذ اعتمد التعليم البدائي (التعليم المسيحي) على ذكريات حياة يسوع كمواد توضيحية (معجزات الشفاء، والأمثال، إلخ). وبالمثل، وُجدت مجموعات صغيرة من تعاليم يسوع الأخلاقية لتلبية الحاجة إلى قواعد بسيطة لهداية المسيحيين. هذه القواعد يمكن حفظها عن ظهر قلب.
ينشأ شكل الإنجيل من التقاء هذين الشكلين من التقاليد المتعلقة بيسوع، كتطورٍ إضافيٍّ لأساليب التعليم والوعظ المقبولة. ومن المرجح جدًا أن يكون مرقس هو من ابتكر هذا الشكل. وهو يتوافق مع الاحتياجات المتغيرة، مع ابتعاد الكنيسة عن أصولها وتطورها لحياة داخلية أكثر تعقيدًا. كان من الضروري تقديم وصفٍ دقيقٍ للمعتقدات المسيحية المميزة في مواجهة تحريف التقليد الأصلي (راجع لوقا ١: ١-٤). يتوافق هذا مع دافع يوحنا في تبني شكل الإنجيل، ويشير إلى أنه يكتب في المقام الأول لمن هم داخل الكنيسة لا للغرباء.
إن استخدام يوحنا لهذا الشكل يضع إنجيله في نفس فئة الأناجيل الإزائية.3 لكن هذا يثير بشكل أكثر حدة مشكلة علاقته بها. فهو لا يستخدم سوى عدد قليل من الأحداث السيرية (الآيات)، ويجعلها أساسًا لخطابات مطولة، لا مثيل لها في الأناجيل الإزائية؛ وفي التفاصيل، غالبًا ما يكون سرده متناقضًا معها. وهذا يثير مشكلة تاريخية جوهرية، إذ لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحًا. وقد ظهرت هذه المعضلة بمجرد انتشار الإنجيل الرابع في القرن الثاني. يقول قانون موراتوري (170م) إن يوحنا كتب نيابةً عن أندراوس والرسل الآخرين – من الواضح أنه أراد بذلك طمأنة المشككين في صحة الإنجيل. تجاوز الإسكندريون الصعوبة بوضع يوحنا على مستوى مختلف: “وأخيرًا، أدرك يوحنا أن الحقائق الخارجية (ta sõmatika ) قد أصبحت واضحة في الأناجيل، وحثه أصدقاؤه وألهمه الروح القدس، فألف إنجيلًا روحيًا ( pneumatikon … evangelion).”4 حتى أن أوريجانوس يقترح أنه لا يمكن ولا يجب التوفيق بين التناقضات، لأن احتياجات الحقيقة الروحية تتطلب التخلي عن الدقة التاريخية الصارمة (تعليقات على يوحنا 10: 4-6). هذا الموقف له نظير حديث في حجة هوسكينز أن يوحنا كان يعرف، ويتوقع من قرائه أن يعرفوا، المادة الإزائية (ليس بالضرورة الإزائية كما لدينا)، لكنه قدمها بشكل مختلف لإظهار معناها الحقيقي. وبالتالي فإن يوحنا هو المفتاح للآخرين.
ظلت المشكلة حادة طالما ساد الاعتقاد بأن يوحنا كان على دراية فعلية بالأناجيل الإزائية. كان بوركيت متشككًا صراحةً في القيمة التاريخية ليوحنا. لكن شنيفيند (1914)، ووينديش (1926)، وغاردنر-سميث (1938)، وويلكنز (1958) شككوا في فكرة الاعتماد المباشر. ورغم أن هوارد وباريت وبيلي ما زالا يُصران عليها إلى حد ما، إلا أن معظم الباحثين اليوم يُفضلون الرأي القائل بأن يوحنا استخدم تقاليد موازية مستقلة. ويجب أخذ ثلاثة عوامل في الاعتبار.
(أ) ترتيب المواد. يُفسح يوحنا المجال لخدمة يسوع في اليهودية، وهي خدمة لم تكن معروفة للأناجيل الإزائية (٢: ٢٢). كما يُصعد يسوع إلى أورشليم للاحتفال بالأعياد (٢: ١٣؛ ٥: ١؛ ٧: ٢؛ ١٠: ٢٢). ويضع تطهير الهيكل في بداية الخدمة (٢: ١٣-٢١) بدلًا من نهايتها (مرقس ١١: ١٥-١٩). من ناحية أخرى، تتوافق سلسلة الأحداث في الأصحاحات ٥ و٦ و٩ تقريبًا مع تسلسل مرقس . ولكن بما أن أبرز السمات تكمن في الأصحاح ٦، وهو على الأرجح إضافة إلى الشكل الأصلي للإنجيل (انظر أدناه، ص 19)، فلا يُمكن استنتاج الكثير من هذا. ومن المُرجح أن تطهير الهيكل كان أيضًا من ضمن الأناجيل الإزائية في الأصل. ولكن في الحقيقة، لا يهتم يوحنا ولا الأناجيل الإزائية كثيرًا بالتسلسل التاريخي، لذا فإن الحجة القائمة على ترتيب الأحداث لا تُقدم دعمًا يُذكر لأيٍّ من الاتجاهين.
(ب) المادة المشتركة. يشترك يوحنا في العديد من الأحداث مع الأناجيل الإزائية (معمودية يسوع، دعوة التلاميذ، تطهير الهيكل، شفاء ابن أحد المسؤولين، إلخ). ولكن في كل مرة، يتغير الزمان أو المكان، ويُصوَّر المشهد بأكمله بشكل مختلف. علاوة على ذلك، هناك الكثير من المواد الإزائية التي تخص يوحنا (عرس قانا الجليل، مثل الراعي، إقامة لعازر). نادرًا ما تُظهر أقوال يسوع التي لها نظائر إزائية توافقًا لفظيًا. لا يمكن أن تُعزى جميع الاختلافات بين يوحنا والأناجيل الإزائية إلى هدفه اللاهوتي، بل الأرجح أنها تعود إلى المصادر غير الإزائية، التي استُمد منها مادته الإضافية. ليس من الضروري الإقرار بأن هذه المصادر كانت شفهية تمامًا كما قال نوآك.
(ج) الروابط اللفظية الدقيقة. وهي قليلة، ولكنها بارزة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. وهكذا فإن يوحنا 5: 8 = مرقس 2: 9، بما في ذلك الكراباتون العامية، التي تجنبها متى ولوقا؛ ويوجد في يوحنا 6: 7 “مائتي دينار”، تمامًا كما هو الحال في مرقس 6: 37؛ ويوحنا 12: 1-8، المسحة في بيت عنيا، لها روابط أكثر إثارة للإعجاب مع نسختي مرقس ولوقا للقصة. ويضطر براون إلى افتراض أن هذه الروابط ترجع إلى محرر نهائي (الذي أضاف أيضًا الفصل 21)، والذي كان على دراية بمرقس. ويفترض بواسمارد أن لوقا نفسه كان المحرر النهائي. ويجب أن تسمح نظرية مصدر مثل نظرية بولتمان بالاتصال إما في المرحلة السابقة -أي في مصدر الآيات- أو في العمل النهائي للمحرر الكنسي. لكن الصعوبة تُذلل إذا افترضنا أن مصادر يوحنا كانت في بعض الأحيان مطابقة، أو قريبة، من المصادر التي استخدمها مرقس ولوقا. ولا يوجد ما يمنع كتابة بعض هذه المصادر على الأقل.
إذا لم يستخدم يوحنا الأناجيل الإزائية، فإن المجال مفتوح لتقييم مستقل للقيمة التاريخية لمادته. لا يمكن الجزم بأنه أكثر موثوقية من الأناجيل الإزائية، أو أقل منها. يجب النظر إلى كل بند على حدة.
السؤال الحاسم هو مدى سلطة يوحنا نفسه كناقل للتقاليد. وهذا يعتمد على هويته. ومن ثم، فإن مسألة التأليف مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشكلة المركزية للإنجيل الرابع.
3. التأليف
1. يوحنا الرسول
الرأي التقليدي هو أن مؤلف الإنجيل هو يوحنا بن زبدي، وأنه الشخص المشار إليه في الإنجيل نفسه بـ “التلميذ الذي أحبه يسوع”. ولا يزال لهذا الرأي مؤيدوه.5 حتى أن بعض المعلقين النقديين مثل براون وشناكنبورغ يتمسكون به إلى حد ما. لكن الاعتراضات عليه هائلة6.
بادئ ذي بدء، يجب ملاحظة أن نسبة الإنجيل إلى الرسول يوحنا لا يمكن إرجاعها إلى الأيام الأولى. يبدو أن جوستين الشهيد، الذي كتب في منتصف القرن الثاني، يتضمن ذكريات طفيفة عن الإنجيل الرابع (1 رؤيا يوحنا 61؛ ديال 112 ؛ 838؛ 91). ولكن عندما يتحدث عن يوحنا (ديال 162: 3) فإنه لا يذكر الإنجيل، على الرغم من أنه ينسب إليه سفر الرؤيا (ديال 83: 4). وبالتالي، فقد تم تحديد يوحنا الرسول بالفعل مع يوحنا المذكور في رؤيا يوحنا 1: 4، 9، ولكن ليس مع الإنجيلي. وبحلول وقت عظة فصح ميليتو من ساردس (حوالي 165 م)، كان استخدام الإنجيل الرابع مؤكدًا، ولكن لا يوجد حتى الآن ذكر ليوحنا بالاسم. للاطلاع على دليل بابياس، انظر أدناه.
ومع ذلك، كان الإنجيل معروفًا ومُقدَّرًا بالفعل من قبل الغنوصيين الفالنتينيين، الذين وجدوا فيه الكثير مما يدعم آرائهم الهرطقية. يقتبس إيريناوس ( I.viii.5Adv. Haer) شرح بطليموس للمقدمة، التي ينسبها إلى “يوحنا، تلميذ الرب”. من الواضح أن هذا تلميح إلى التلميذ الحبيب، ويشير إلى أن تحديد هوية المؤلف مستمد من الدليل الداخلي للإنجيل نفسه. وقد قيل بشكل معقول أن الفالنتينيين كانوا أول من حددوا هويته مع يوحنا الرسول، حيث أن سلطة اسم الرسول ستعزز قضيتهم بشكل طبيعي. لقد نجحوا لدرجة أن بعض المسيحيين رفضوا الإنجيل الرابع باعتباره عملاً هرطوقيًا. وهكذا يتحدث هيبوليتوس عن “الألوجي”، الذي نسب كل من الإنجيل ورؤيا يوحنا إلى سيرينثوس الغنوصي 7. يبدو أن سفر أعمال يوحنا (وهو عمل شعبي هرطوقي من منتصف القرن الثاني ) لا يعلم أن يوحنا هو مؤلف الإنجيل، مع أنه استخدمه على ما يبدو. وهو أقدم عمل يربط يوحنا بأفسس.
بحلول ذلك الوقت، بدأ آباء الكنيسة الذين قبلوا الإنجيل الرابع يقبلون أيضًا ادعاء التأليف الرسولي، مع أن كلاً من قانون موراتوري وإكليمندس الإسكندري يشهدان على قدر من الشك فيه (راجع أعلاه، ص 7). أول تصريح لا يقبل الجدل هو تصريح إيريناوس (المحامي هاير … إذا … ): “ثم نشر يوحنا، تلميذ الرب، الذي اتكأ على صدره، الإنجيل بنفسه، أثناء إقامته في أفسس بآسيا”. بعد ذلك، أصبح نسب الإنجيل إلى يوحنا الرسول مقبولًا بشكل عام. كان لاغرانج يميل إلى إعطاء وزن لإجماع الآباء، ولكن يبدو أن التقليد يعود في الواقع إلى الفالنتينيين، الذين استنبطوه هم أنفسهم من الأدلة الداخلية للإنجيل نفسه. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذا، من الضروري مراجعة أدلة بابياس، التي استُخدمت لدعم نظرية أخرى حول نسب الإنجيل إلى يوحنا الرسول، أي ليس إلى يوحنا الرسول، بل إلى شيخ يحمل الاسم نفسه.
2. يوحنا الشيخ
فُقدت الكتب الخمسة لشرح بابياس لأقوال الرب؛ لكن جزءًا من الكتاب محفوظ لدى يوسابيوس ( III.xxxix. 1-7HE) يروي كيف جمع بابياس معلوماته في نهاية القرن الأول: “إذا جاءني أحدٌ ممن كانوا يتبعون الشيوخ، استفسرتُ عن أقوال الشيوخ – عما قاله أندراوس أو بطرس، أو ما قاله فيلبس، أو ما قاله توما أو يعقوب، أو ما قاله يوحنا أو متى أو أيٌّ من تلاميذ الرب، وما قاله أريستيون ويوحنا الشيخ، تلميذا الرب. لأني ظننتُ أن ما جاء في الكتب لن يكون نافعًا لي بقدر ما يكون من صوتٍ حيٍّ (حرفيًا: “صوتٌ حيٌّ باقي”).” يشير يوسابيوس إلى أن بابياس يذكر هنا إثنين يوحنا، الأول مات الآن (ويفترض يوسابيوس أنه الإنجيلي)، والثاني لا يزال حيًا (وينسب إليه سفر الرؤيا). جيروم (دي فيريس إنل de viris inl. xviii) يُورد نفس الاقتباس من بابياس، ولكنه يُشير على نحوٍ أكثر منطقية إلى أن يوحنا الشيخ هو كاتب رسالتي يوحنا الثانية والثالثة، حيث يُطلق الكاتب على نفسه لقب “الشيخ” ( presbyteros ). لا يُشير هذا اللقب بالضرورة إلى منصب رسمي، ولكن يُمكن أن يُطلق على أي مُعلّم مُبجّل، كما هو الحال في الاستخدام اليهودي (راجع مرقس ٧: ٥).
ومع ذلك، ومهما كان رأي يوسابيوس وجيروم، فمن الواضح أن بابياس نفسه لا يملك أي معرفة بالإنجيل، ولا ينسبه إلى أيٍّ من الاثنين يوحنا. وقد تُرك للعلماء المعاصرين اقتراح يوحنا الشيخ كإنجيلي. افترض هارناك، ثم برنارد، أن يوحنا الشيخ كتب الإنجيل بناءً على تعليم الرسول، وخلطت التقاليد اللاحقة بين الاثنين يوحنا. ولكن لا يوجد دليل قاطع على هذه النظرية التي عند بابياس. إنها مجرد استنتاج، تدعمه الكلمات الافتتاحية لرسالتي يوحنا الثانية والثالثة، اللتين يُفترض أنهما من نفس اليد التي كتبت الإنجيل ورسالة يوحنا الأولى. لذلك، لا نُعفى أنفسنا من ضرورة إيلاء الاهتمام الأساسي للأدلة الداخلية.
3. يوحنا في أفسس
قبل أن نترك الأدلة الآبائية، هناك نقطة أخرى حول الصلة بين يوحنا الرسول وأفسس، سبق ذكرها. يروي بوليكراتس، أسقف أفسس (حوالي ١٩٠م)، بفخرٍ عن الأبطال المسيحيين المدفونين هناك، ويتابع: “وعلاوة على ذلك، يوحنا، الذي اضطجع على صدر الرب، وكان كاهنًا يرتدي الصفيحة، راجع خروج ٢٨: ٣٦)، وكان شاهدًا وتلميذًا – وهو أيضًا راقد في أفسس (يوسابيوس، III.xxxi.4HE). في الواقع، كان هناك قبران، يربطهما يوسابيوس (.6III.xxxix) بالإثنين يوحنا اللذين ذكرهما بابياس.
لكن أي صلة بين الرسول وأفسس، بل وأي احتمال لكونه مؤلف الإنجيل، قد تم الطعن فيه بنظرية استشهاده مع يعقوب (أعمال الرسل 12: 2). وعلى الرغم من قبول العديد من العلماء المعاصرين (ويلهاوزن، موفات، بيكون، بوركيت)، إلا أنه يجب اعتبار هذا الرأي في الواقع بمثابة رنجة حمراء؛ في الواقع، يبدو أنه استنتاج من مرقس 10: 39 بشأن مصير ابني زبدي. يقدم فيليب من سيدا (حوالي 430 م) اقتباسًا آخر من بابياس مفاده أن يوحنا اللاهوتي ويعقوب أخاه قُتلا على يد اليهود. ولكن، على الرغم من وضع الأخوين بين قوسين بهذه الطريقة، فقد يعني بابياس أن استشهاد يوحنا كان لاحقًا كثيرًا من استشهاد يعقوب، ويجب أن تكون هذه بالتأكيد هي الطريقة التي فهم بها فيليب الأمر، حيث أنه ينسب إليه الإنجيل ورسالة يوحنا الأولى ورؤيا يوحنا.
يقتبس سجل جورج الراهب (القرن التاسع) أيضًا هذا المقطع من بابياس، ويربطه مباشرةً بمرقس ١٠: ٣٨ وما يليه. يقتبس من أوريجانوس (. التعليقات على متى ١٦: ٦) أن يوحنا استشهد، لكنه يشير إلى أن يوسابيوس ( III.i.IHE) يتحدث عن وفاته في أفسس. لذا، يبدو مجددًا أن استشهاد يوحنا جاء بعد استشهاد يعقوب بفترة طويلة. في الواقع، ربما يكون وراء هذه الإشارات التباس في كلمة martys اليونانية، والتي قد تعني شاهدًا بالمعنى القانوني وشهيدًا بمعناها الحديث؛ وقد يُشجع مرقس ١٠: ٣٩ هذا الالتباس.
يقدم باريت أدلة إضافية من سجلين للاستشهاد. سجل استشهاد سرياني يعود إلى عام ٤١١ ميلادي يذكر في ٢٧ ديسمبر: “يوحنا ويعقوب الرسولان في القدس”؛ بينما يذكر تقويم قرطاج (٥٠٥ ميلادي) في اليوم نفسه: “إحياء ذكرى يوحنا المعمدان ويعقوب الرسول الذي قتله هيرودس (يشير استخدام المفرد إلى يعقوب فقط). وحتى لو كان من المرجح أن تكون كلمة “المعمدان” ذكرت خطأً بدلا من “الرسول”، فإن هذا لا يثبت الاستشهاد في اليوم نفسه. لا يمكن البناء على هذه الشهادة الهشة.
4. التلميذ الحبيب
بالانتقال إلى الأدلة الداخلية، من البديهي أن أول ما يجب علينا فعله هو النظر في ادعاء أن التلميذ الحبيب هو المؤلف، إذ ورد هذا في الملحق (٢١: ٢٤). ومن الضروري أيضًا البت في صحة التعريف التقليدي له بيوحنا الرسول.
(أ) يُذكر “التلميذ الذي أحبه يسوع” بهذا الاسم فقط في العشاء الأخير (١٣: ٢٣)، والصلب (١٩: ٢٦)، والقبر الفارغ (٢٠: ٢)، وفي الملحق (٢١: ٧، ٢٠). ولكنه قد يكون التلميذ المجهول في ١: ٣٥ (التلميذ الآخر هو أندراوس، ١: ٤٠). وقد يكون أيضًا “التلميذ الآخر” الذي دخل بيت رئيس الكهنة (١٨: ١٥ وما يليه)، وقد يكون شاهدًا على طعن جنب يسوع (١٩: ٣٥). عندما تُجمع كل هذه الإشارات في ضوء ٢١: ٢٤، تظهر صورة متسقة وجذابة. إنه أحد التلاميذ الأوائل، ويحظى بمكانة خاصة في محبة يسوع. يظهر هذا في العشاء الأخير، وأيضًا في تسليم يسوع أمه إلى رعايته. علينا أن نفترض أنه عاد بعد أن أخذها إلى بيته (١٩: ٢٧)، إذا كان شاهدًا على ١٩: ٣٥. لكن الأهم هو أنه كان أول من آمن بالقيامة. لاحقًا، يُنبئ سرًا بحياته الطويلة (٢١: ٢٢). وأخيرًا، يشهد أحد المحررين على كتابته للإنجيل، كشاهد عيان بعد الأحداث بوقت طويل.
ولكن على الرغم من جاذبيتها، فإن هذه الصورة مفتوحة لاعتراضات خطيرة. ( أ ) لا يوجد ما يبرر رؤية إشارة إلى التلميذ الحبيب في 1. 35، ولا يوجد أي تلميح هناك إلى أن الشخص الذي لم يُذكر اسمه سيكتسب أهمية في نهاية القصة. وبالمثل، يجب استبعاد “التلميذ الآخر” في 18. 15 وما يليه من الاعتبار، حيث أن تسميته بأنه “الذي أحبه يسوع” غير موجودة (المقارنة 20. 2). كما تفتقر شهادة الطعن (19. 35) إلى الوصف المناسب؛ في الواقع، قد تكون هذه الآية مجرد تعليق (انظر الملاحظات في نفس المكان). ومن الواضح أنه إذا أمكن اعتبار هذه الآية بثقة إشارة إلى التلميذ الحبيب، فسيعزز ذلك الادعاء بأنه المؤلف. ولكن يجب استبعادها؛ فالإشارات الموثوقة الوحيدة إليه هي 13. 23؛ 19. 26؛ 20. 2؛ والملحق.
(٢) يمكن اعتبار القصة الواردة في الملحق (٢١: ١-٢٣) عملاً أصيلاً للإنجيلي، حتى وإن لم تكن جزءًا من الإنجيل. هنا، وهنا فقط، تُعدّ شخصية التلميذ الحبيب موضوعًا للتكهنات. لكن الفكرة الأساسية هي أنه ما كان ينبغي طرح السؤال عن مستقبله (الآية ٢١). يُطالب يسوع بأمر وجودي (“اتبعني!”، الآية ٢٢)، ويرفض إعطاء إجابة مباشرة. إذًا، كان القصد من القصة وضع حدٍّ للتكهنات حول التلميذ الحبيب، والتي نشأت من الإنجيل المكتمل. لكن أسلوب الإنجيلي ترك جوًا من الغموض لم يُثر سوى المزيد من التكهنات! استنتج أحد مروجي الإنجيل أن سبب إخفاء هوية التلميذ هو أنه في الواقع الكاتب نفسه. لذلك أُضيفت الآية ٢٤، وربما أيضًا ١٩: ٣٥.
(٣) لكن فكرة أن العنوان هو تسمية ذاتية للمؤلف بعيدة كل البعد عن الإقناع 8. ومن المؤكد أنها تقود إلى استنتاج أن المقاطع الثلاثة في الأصحاحات ١٣ و١٩ و٢٠ التي يظهر فيها هي روايات شهود عيان. لكن لهذه الحوادث الثلاثة أوجه تشابه في الأناجيل الإزائية التي لا يلعب فيها التلميذ الحبيب أي دور. وسيتضح في الشرح أن مصادر يوحنا في هذه النقاط الثلاث كانت قريبة من الروايات الإزائية. إن وجود التلميذ ووظيفته في عرض يوحنا لها تحديدًا هو ما يصعب تفسيره تاريخيًا. وهذا يقودنا إلى سؤالنا الثاني: من هو التلميذ الحبيب حقًا؟
(ب) لطالما اعتُرف بأن يوحنا الرسول هو المرشح الأوفر حظًا. ولتأييد هذا التعريف، يُجادل البعض بأنه، وفقًا للأناجيل الإزائية، كان أحد المجموعة الداخلية المكونة من ثلاثة أشخاص حضروا إقامة ابنة يايرس، والتجلي، وجثسيماني. لكن هذا ليس حجة، لأن الإنجيل الرابع لا يتضمن أيًا من هذه المناسبات الثلاث التي تُخص فيها المجموعة بالذكر بشكل خاص. صحيح أن لوقا يذكر يوحنا مع بطرس (لوقا ٢٢: ٨؛ أع ٣: ١، ١١؛ ٤: ١٣؛ ٨: ١٤)، لكن هذا لا يُثبت شيئًا في أيٍّ من الحالتين. وأخيرًا، يُدرج الملحق سبعة تلاميذ، من بينهم “ابنَا زبدي، واثنان آخران من تلاميذه” (٢١: ٢). ومن الواضح أن “ذلك التلميذ الذي أحبه يسوع” في الآية ٧ يجب أن يكون واحدًا من هؤلاء الأربعة؛ لكن حرص المؤلف الشديد على إخفاء هويته يُرجّح أن يكون أحد الشخصين المجهولين، وليس أحد ابني زبدي. وبالتالي، فإنّ تحديد هويته بيوحنا الرسول ليس فقط غير مُثبت، بل هو أيضًا موضع شكّ واضح. ومن الاقتراحات الأخرى:
(i) لعازر (فليمنج، فيلسون، ساندرز، إيكهارت)، لأن عودته إلى الحياة (١١: ٤٤) وارتباطه بيسوع (١٢: ٩-١١) يُفسران ذكر التلميذ لأول مرة في العشاء الأخير (١٣: ٢٣). العامل الأساسي هو أن “يسوع أحب… لعازر” (١١: ٥، قارن الآيات ٣، ١١، ٣٦). لكن هذه النظرية ضعيفة: فإذا ذُكر اسم التلميذ في هذه المقاطع، فمن الصعب فهم سبب عدم ذكره في الفصول ١٣، ١٩، و٢٠. ولكن، بما أن الإنجيلي أضاف على الأرجح الآيات ١١: ١-٤٤ و١٢: ٩-١١ إلى الطبعة الثانية من عمله (انظر أدناه، ص 19)، فيمكن القول إنه قرر التخلي عن إخفاء هوية التلميذ في هذه المرحلة. ومع ذلك، فإن هذا لا يفسر إخفاء هويته بشكل متقن في الملحق.
(ii) يوحنا مرقس (ويلهاوزن، باركر)، نظرًا لنسب الإنجيل إلى “يوحنا”، ولأن منزله كان، على ما يبدو، مقر الكنيسة الأولى في أورشليم (أعمال الرسل ١٢: ١٢). يعتقد البعض أنه لم يكن التلميذ الحبيب، بل المبشر الذي استخدم ذكريات التلميذ (ساندرز: استخدم مرقس ملاحظات لعازر، التي كانت مكتوبة بالآرامية؛ مارش: استخدم مرقس تقاليد مستمدة من يوحنا الرسول). إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن نسب الإنجيل الثاني إلى مرقس. ولكن لا يوجد دليل على صلته بالإنجيل الرابع. إن إقحام يوحنا آخر على هذه الأسس الضعيفة يزيد من الالتباس.
(iii) بولس (ب. و. بيكون)، استنادًا إلى غلاطية ٢: ٢٠ («الذي أحبني»)، هو رجوعٌ لشخصيةٍ لاحقةٍ إلى الماضي. هذا الاقتراح غريب. وماتياس (إل. تيتوس) بعيد الاحتمال بنفس القدر.
يجب أن تؤخذ هوية التلميذ الحبيب مجهولة على محمل الجد: لم يرغب يوحنا في أن تُعرف هويته. وهذا يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان يمكن اعتباره بحق شخصية يمكن التعرف عليها تاريخيًا على الإطلاق. قد يكون حينها شخصية مثالية ( لويزي، بولتمان). يجب أن نكون حريصين هنا على إبقاء القضايا منفصلة. من المؤكد أن للتلميذ وظيفة رمزية باعتباره التلميذ المثالي، الذي يظل صادقًا حيث يفشل بطرس (إنه ليس بالضرورة من نوع الكنيسة الأممية، كما يفترض بولتمان). ولكن هذا لا يعني أنه ليس من المقصود أن يكون شخصًا تاريخيًا فعليًا: فهو بالتأكيد أحد الاثني عشر. لكن يوحنا شعر بالحاجة إلى تمثيل أحدهم باعتباره التلميذ المثالي. لقد استغل عدم وجود وجه لمعظمهم في التقليد ليفرض على أحدهم السمات اللازمة لغرضه. يعرف يوحنا أن بطرس كان قائد الاثني عشر (راجع 6. 68)؛ لكن فشل بطرس وقت محاكمة يسوع جعله غير مؤهل للوظيفة التي كان على يوحنا أن يمثلها في تلك المرحلة، أي شخصًا لا ينكر آلام المسيح، بل يخترقها إلى القيامة. يتطلب هذا الدور رسولًا أكثر فطنة ووفاءً من بطرس، وأقرب إلى فكر يسوع. لم يتضمن التقليد مرشحًا واضحًا لهذا المنصب بين الاثني عشر، وقد قرر يوحنا بحكمة ألا يُلزم نفسه بأيٍّ منهم.
5. مؤلف الإنجيل
لم يُسفر بحثنا عن مؤلف الإنجيل الرابع إلا عن نتائج سلبية. ونسبته إلى يوحنا الرسول ليس مُبرَّرًا. فالتلميذ الحبيب ليس هو المؤلف، ولا حتى الشخص الذي كان بإمكانه تقديم معلومات من شهود عيان، على الرغم من الآية ٢١: ٢٤. ببساطة، لا نعرف من هو المؤلف؛ وسيُدعى في هذا التفسير “يوحنا” حرصًا على العرف والسهولة.
يترتب على ذلك أن الإنجيل الرابع لا يدعي موثوقية تاريخية خاصة. في الواقع، إن النهج الخيالي في وصف الشخصيات، المتمثل في شخصية التلميذ الحبيب، يحذرنا من المبالغة في تصديق التفاصيل الظرفية العديدة للرواية. من ناحية أخرى، لا يزال بإمكاننا الاعتقاد بأن يوحنا يمتلك مصادر ممتازة. علاوة على ذلك، يمكننا معرفة المزيد عنه من خلال دراسة خلفية فكره.
4. خلفية الفكر
حظي الإنجيل الرابع بتقدير الغنوصيين لتوافقه مع فكرهم اليوناني. كما حظي بتقدير مماثل في العصر الحديث لروحانيته الصوفية، لا سيما من قِبل فون هوغل 9، وكثيرًا ما بحث العلماء عن أصول أفكاره في الفكر التأملي الهلنستي. وفي الآونة الأخيرة، اتجه الاهتمام إلى الخلفية اليهودية، وخاصةً في أعمال هوسكينز وباريت. وقد ثبت ذلك بشكل لافت من خلال اكتشاف مخطوطات البحر الميت.
في الواقع، يجب التمييز بدقة بين خلفية فكر المؤلف وخلفية قرائه. من الواضح أنه يكتب بناءً على خلفيته الخاصة، ولكن سيتعين عليه التكيف مع خلفية قرائه إلى حد ما، إذا كانت خلفيتهم تختلف اختلافًا كبيرًا عن خلفيته. في حالة الإنجيل الرابع، من الواضح أن المؤلف يستمد فكره من التراث اليهودي والمسيحي ؛ ولكن من المرجح تمامًا أنه يكتب لليونانيين، ويضع أسلوب تفكيرهم في اعتباره.
1. الخلفية المسيحية
لقد ثبت بالفعل أن اختيار يوحنا لشكل الإنجيل يجعله متوافقًا مع الكرازة البدائية. يقبل يوحنا أبوة الله، وفكرة الله الخالق الوحيد (رغم وجود قدر من الثنائية)، ومسيحانية يسوع. وهو حاسم تمامًا بشأن إنسانية يسوع الحقيقية، مشددًا على الجسد (1: 14)، ربما كرد فعل على الدوسيتية (انظر أدناه، الصفحات 61 وما بعدها). ويفترض وجود مؤسستي المعمودية (4: 1) والقربان المقدس (6: 52-8). إن تأكيده على دور الإيمان في التمسك بيسوع، وعلى فكرة المحبة كتعبير عن الطاعة الأخلاقية، كان لهما نظراء في كل من التقليد الإزائي ورسائل بولس.
لكن مسيحية يوحنا، كمثل مسيحية بولس، مسيحية متطورة. كلاهما يعتبر يسوع كائنًا سابقًا، مستخدمًا مصطلحات الحكمة اليهودية ( يوحنا ١: ١-١٨؛ كولوسي ١: ١٥-١٧)، ويسميانه “ابن الله”، ليس مجرد تسمية مسيانية (راجع مزمور ٢: ٧)، بل كواقع ميتافيزيقي. يُشكل كلٌّ من الصلب والقيامة العملَ المحوري للفداء، مع أن بولس يفكر من منظور التبرير (رومية ٥)، بينما يفكر يوحنا من منظور النصر على قوى الشر (١٢: ٣١ وما يليه؛ ١٤: ٣٠؛ ١٦: ٣٣). إن كلا منهما يحتفظ بعلم الأخرويات المتسق الذي أعطى لرسالة يسوع مثل هذه الصفة المُلحَّة، ولكن بالنسبة لكليهما فإن مركز الثقل قد تحول من الاستعداد للملكوت القادم إلى مفهوم “الوجود في المسيح” (رومية 8؛ يوحنا 15)، وهو ما يطرح مطلبًا أخلاقيًا صارمًا بنفس القدر.
لكن فكر يوحنا ليس مستمدًا من بولس. بل هو في بعض النواحي أكثر بدائية، كما في استخدامه لشخصية ابن الإنسان. ينبع هذا من التقليد الإزائي، ولكنه لا يزال مرتبطًا بشكل واضح بالصورة الأساسية في دانيال 7: 13؛ لكنه لا يملك نموذج آدم الذي اعتمده بولس، والذي يستند إليه. مرة أخرى، لا نجد فكرة يوحنا عن المجد الذي ظهر في آلام المسيح عند بولس، وعلى العكس من ذلك، لا مكان لعقيدة بولس عن “الجسد” في يوحنا. لكن يبدو أن يوحنا أحدث من بولس: فالجدل حول التهويد، الذي كان مهمًا جدًا لبولس، أصبح شيئًا من الماضي؛ وفي يوحنا، يكاد الانفصال عن المجمع أن يكون كاملًا، إن لم يكن كاملًا تمامًا، بينما لا يزال بولس يأمل في كسب اليهود للمسيح. كذلك، يفترض يوحنا أن للكنيسة حياة طبيعية راسخة؛ بينما ينشغل بولس بمشاكل المسيحية الناشئة.
2. الخلفية اليهودية
إذا كان يوحنا مرتكزًا بقوة على الكيريغما (kerygma) المسيحية ، فإنه يتبع ذلك انتمائه إلى منبعها اليهودي؛ فلا توجد أي محاولة مرقيونية لفصل الكنيسة عن جذورها اليهودية. لذا، يُدرج يوحنا العديد من الاقتباسات من العهد القديم، التي لا تُعيد إنتاج مقاطع شائعة في التقليد المسيحي فحسب (مثل إشعياء 6: 10، المقتبس في 12: 40؛ قارن مرقس 4: 12)، بل تُظهر أيضًا معرفة بالسياق الأوسع (قارن 6: 31؛ 12: 41). كما يستخدم يوحنا بشكل واسع موضوعات العهد القديم، مثل الخلق وظهور الله في سيناء (1: 1-18)، والسرديات الأبوية (4: 12)، وابن الإنسان، وأفكار القيامة في دانيال. 7 و 12 (5: 19-29)، المن والناموس (6: 25-51)، النصوص المسيحانية (7: 41 وما يليها)، قصة إبراهيم (8: 56)، إلخ. 10
لكن معرفة يوحنا اليهودية لا تقتصر على التعليم من الكتب فحسب، بل يقدم تفاصيل طبوغرافية عديدة عن القدس وضواحيها، مما يوحي إما بمعرفة شخصية بالمواقع، أو على الأقل بمعلومات مفصلة للغاية. كما أنه مُلِمٌّ بالعادات اليهودية: فهو مُلِمٌّ بالأعياد (عيد الفصح، “العيد” = المظال، التكريس) والطقوس المرتبطة بها (٧: ٣٧)، ويعلم عن طقوس التطهير (٢: ٦)؛ ويعرف عن السامريين، ويفهم علاقتهم باليهودية الرسمية (٤: ٢٠-٢٥). † كما أنه قادر على ترجمة مصطلحات تقنية (مثل: المسيح، ربوني).
علاوة على ذلك، فإن يوحنا على دراية بالنزاعات الحاخامية المعاصرة. تتضمن الحجة حول السبت في 5. 17 نقطة خلاف لا توجد في جوانب الأناجيل البدائية. يدور خطاب الفصل 6 حول معادلة حاخامية بين المن والشريعة المعطاة في سيناء، ويتضمن أيضًا حجة حاخامية محددة (6. 45). تُعرف فكرة المسيح الخفي (7. 27) من المصادر الحاخامية، ولكنها غير موجودة في العهد القديم. خطاب الفصل 8 هو أيضًا حاخامي تمامًا في الأسلوب. نحن نتعامل هنا مع جانب من جوانب الإنجيل لا يمكن أن يُعزى إلى مصادر جيدة، ولكنه جزء أساسي من محتواه وأسلوبه. من الطبيعي جدًا أن نستنتج مع بوكر أن يوحنا كان على اتصال شخصي بالمناقشات اليهودية والمسيحية.11 وهذا يشير إلى أن العمل قد بدأ قبل استبعاد المسيحيين من الكنيس (حوالي 85 م)، وانتهى بعد ذلك بقليل.
يُعزز هذا الاستنتاج موقف الإنجيل من اليهود. فلا نسمع أي ذكر للصدوقيين، وهم الفريق الرائد في زمن يسوع، ولا للغيورين، الذين يُرجّح أن يكون أحد الاثني عشر منهم (سمعان القانوي، مرقس 3: 18). يُذكر الفريسيون فقط، وهم القادة بلا منازع. وهذا يعكس الوضع بعد الحرب اليهودية بين عامي 68 و73 ميلاديًا، عندما قُضي على الصدوقيين والغيورين تقريبًا، وبقي الفريسيون وحدهم في ولاء اليهود.
يرتبط يوحنا أيضًا ارتباطًا وثيقًا بفكر مخطوطات البحر الميت. فعلى الرغم من الاختلافات العميقة بين طائفة قمران (التي يُعرّفها كثير من الباحثين بالإسينيين) والكنيسة الأولى، إلا أنها تُمثّل، من بعض النواحي، أقرب تشابه فكري في اليهودية في زمن يسوع. فكما فعل المسيحيون، اعتبر أتباع هذه الطوائف تاريخهم تحقيقًا للنبوءة؛ وكان لديهم توجهٌ أخرويٌّ مماثل، وتعاملوا مع الكتاب المقدس بنفس الطريقة تقريبًا. علاوةً على ذلك، أظهروا نظامًا فكريًا تضمّن بعض العناصر الهلنستية، أو على الأقل الإيرانية، بحيث لا نضطر إلى النظر خارج اليهودية لتفسير وجودها في المسيحية المبكرة؛ وعلى وجه الخصوص، نجد في المخطوطات أوضح تعبير عن التباين بين النور والظلام، وهو موضوعٌ محوريٌّ في إنجيل يوحنا. يبدأ دليل الانضباط بشرحٍ للروحانية الأساسية للطائفة، حيث يُؤكّد وجود روحين يتنافسان على السيطرة على البشر، يُوصفان أحيانًا بـ”روح الحق” و”روح الضلال”، أو “ملاك النور” و”ملاك الظلمة”. لذا، يتحدث يوحنا عن الشيطان بأنه “أبو الكذب” (٨: ٤٤)، وعن الروح القدس بأنه “روح الحق” (١٤: ١٧؛ ١٥: ٢٦؛ ١٦: ١٣).
يبدو أن تأثير الطائفة على يوحنا لا مفر منه. لكن هذا لم يكن بالضرورة أكثر من اتصالاته باليهودية عمومًا؛ ففي ذلك الوقت، على الرغم من أن الطائفة ربما انتهت بالحرب اليهودية، إلا أن أفكارها كانت على الأرجح واسعة الانتشار ومؤثرة. لم يتحقق عمل الحزب الفريسي المنتصر دفعة واحدة، والأفكار التي رُفضت لاحقًا أو استُبدلت ببساطة ونُسيت قد بقيت لبعض الوقت. علاوة على ذلك، استوعب الحاخامات هذه الأفكار إلى حد كبير عن طريق التكيف بدلاً من رفضها تمامًا، كما تشهد العقيدة الحاخامية للميولين في الإنسان (الميول الصالحة والطالحة)، وهي صورة متطورة لعقيدة الروحين، مجردة من أساسها الثنائي. من الواضح أن العنصر اليهودي في إنجيل يوحنا بالغ الأهمية بحيث لا يمكن اعتباره مستمدًا من استمرار الأفكار اليهودية في الكنيسة فحسب، بل يتطلب اتصالًا فعليًا باليهودية. لكن الأمر نفسه لا ينطبق على قرائه، الذين غالبًا ما يقدم لهم شرحًا للعناصر اليهودية (١: ٤١؛ ٤: ٩؛ إلخ). من المرجح جدًا أنه اضطر إلى مراعاة العناصر الهلنستية في نظرته، وسنتناول هذه العناصر الآن.
3. الخلفية الهلنستية
في القرون الثلاثة التي تلت وفاة الإسكندر الأكبر (323 قبل الميلاد)، اندمجت المراكز الثلاثة للحضارة القديمة – مصر وبلاد ما بين النهرين واليونان – إلى حد كبير في وحدة ثقافية واحدة. قدمت الإنجازات الجمالية لليونان الكلاسيكية الأسلوب السطحي، لكن الديانات الطبيعية للشرق القديم استمرت، على الرغم من أنها أصبحت أكثر تعقيدًا، وتكيفت إلى حد ما مع الفلسفة اليونانية. اخترقت هذه الثقافة الهلنستية اليهودية إلى حد كبير، لكنها واجهت معارضة شرسة من المكابيين عندما حاول أنطيوخس إبيفانيس فرض الأشكال الدينية الشرقية على اليهود في أوائل القرن الثاني قبل الميلاد. لكن المجتمع اليهودي في الإسكندرية وقع تحت تأثير الفكر اليوناني. لذلك نبدأ بالفكر اليهودي الهلنستي في الإسكندرية، والذي يمثله فيلو.
(أ) فيلو
كانت الفترة النشطة في كتابة فيلو في النصف الأول من القرن الأول الميلادي. سعى إلى فهم إيمانه اليهودي في ضوء توليفة الفكر الأفلاطوني والرواقي التي وضعها بوسيدونيوس (حوالي 100 قبل الميلاد). إن هدف الإنسان المتدين هو ربط حياته بالواقع، وذلك لتحقيق غايته الحقيقية – الخلود. ولكن هناك هوة لا يمكن عبورها بين العالم الحقيقي للأفكار الإلهية والعالم الموجود، والذي يخضع للتغيير والانحلال. ومع ذلك، على هذا الأساس الأفلاطوني، فرض مفهوم الكلمة الرواقي. وبهذا “يعني فيلو عالم الأفكار الأفلاطوني، الذي لا يُتصور على أنه موجود بذاته، بل كمعبر عن عقل الإله الواحد”.12 ومن ثم فإن الكلمة (Logos) هو صورة الله، مطبوعة على الأشكال المتعددة للنظام المخلوق. كما أنها موجودة داخل الإنسان، في المقام الأول في ذكائه، مما يمكّنه من إدراك الحقيقة المطلقة وبالتالي الارتقاء إلى الشركة مع الله. فالشريعة، بوصفها التعبير الأمثل عن الكلمة، تُعنى بنشاط النفس. وهكذا يُفرط فيلو في تأويل الكتب المقدسة تأويلًا مُجازيًا، حيث تُعرّف الأشخاص والأحداث بالفضائل والرذائل ونشاط النفس.
نتذكر على الفور سمتين من سمات الإنجيل الرابع: ( 1 ) يتحدث يوحنا عن الكلمة في المقدمة بطريقة مشابهة إلى حد ما. ولكن هذا مستمد من بعض المقاطع الرئيسية، ولا سيما أمثال 8: 22-31 وسير 24، والتي يدين لها فيلو أيضًا. والفرق الحاسم هو أنه في يوحنا، “صار الكلمة جسدًا” (1: 14). لا يوجد لدى فيلو أي شيء من هذا، وهو ما يتعارض بالفعل مع نظامه. في الواقع، لا يُظهر يوحنا أي معرفة بأعمال فيلو، لذلك من المرجح أن يكون هذا التشابه تطورًا موازيًا وليس اقتباسًا مباشرًا (انظر أيضًا الملاحظات على 1: 1). (2) يستخدم يوحنا أحيانًا كلمة alēthinos (“حقيقي، صادق”) بطريقة يمكن مقارنتها بفيلو (1: 9؛ 6: 32؛ 15: 1)؛ ولكن في هذه المقاطع لدينا استعارة، ولكن ليس الاستعارة الفيلونية المميزة . لا يوجد في الواقع أي صلة بين هذا وبين فكر فيلو، والذي يجب استبعاده من التأثيرات على الإنجيل الرابع.
(ب) الأدب الهرمسي
ما أسماه دود Dodd “الدين الأعلى للهيلينية” مُمثل جيدًا في مجموعة هرمس. إنه شكل متطور من الدين المصري، متأثر بالتقاليد الأفلاطونية والرواقية. تحتوي رسالة بويماندريس على العديد من الكلمات والعبارات التي تذكرنا بيوحنا. وفقًا لهذا العمل، يوجد إنسان نموذجي في عالم الأشكال الأبدية، ولا يصل البشر إلى غايتهم النهائية من رؤية الله إلا عندما يتماهون تمامًا مع النموذج الأصلي. لكن أسطورة الخلق (ربما تحت التأثير اليهودي) تعترف بأنه عندما جاء الإنسان النموذجي إلى العالم الحسي ليصبح جنس البشر، حدث فساد، واشتهى البشر مخلوقات أخرى وفقدوا القدرة على رؤية الله. لذا فإن هناك حاجة إلى شكل من أشكال الفداء، وتوضح رسالة أخرى، بيري بالينجينيسياس ، كيف يمكن تطهير الإنسان من خلال إعادة الميلاد من خلال وكالة هرمس تريسميجيستوس، الذي مر بنفسه بهذه العملية. يُذكرنا هذا بإنجيل يوحنا ٣: ٣-١٢، حيث يكون يسوع هو فاعل الولادة الجديدة، كونه الآتي من فوق. ولكن، كما سيتضح في الشرح، ليس من الضروري الخروج عن المصادر المسيحية لتفسير أفكار يوحنا. ولكن قد يكون يوحنا يردد هذا النوع من اللغة في هذه المرحلة لمصلحة القراء الذين يجدون معنىً للتحدث بهذه الطريقة عن السعي الديني.
ج) أسطورة المخلص
تبدو الديانات الغامضة في العالم القديم مثل المسيحية، لأنها تقدم الخلاص للبشر من عجلة القدر من خلال البدء المقدس في أسطورة الإله الذي يموت ويقوم، المستمدة من الطوائف النباتية القديمة في سوريا وآسيا الصغرى. في حين أن هذه تفكر في الخلاص من حيث الأسرار ex opere operato ، استخدمت الغنوصية التي غزت المسيحية في أوائل القرن الثاني أساطير مماثلة للتعبير عن الخلاص من حيث المعرفة السرية التي ينتقل بها البشر إلى العالم الإلهي. في بعض أشكال الغنوصية، يتم نقل هذا من خلال مخلص مرسل من العالم الإلهي (كما في Hermetica )، بحيث يمكن للمرء أن يتحدث عن ” أسطورة المخلص”. يتم التوسط في المعرفة الخلاصية في بعض الأنظمة من خلال نبي، وفي أنظمة أخرى (خاصة في الشكل الدوسيتي للغنوصية المسيحية) من خلال يسوع السماوي، الذي يبدو أنه (ولكنه ليس كذلك حقًا) في شكل بشري. إن لغة يوحنا قابلة للفهم على هذا النحو (راجع 3: 13، 31؛ 6: 62؛ 16: 28؛ 17: 3).
يُطرح السؤال هنا: هل وُجدت غنوصية ما قبل المسيحية استقى منها يوحنا أفكاره؟ يُجادل بولتمان بأن الأمر كان كذلك، وأنها ازدهرت على هامش اليهودية السريانية. ويستند رأيه إلى أناشيد سليمان السريانية، وهي غنوصية بلا شك، وتحتوي على العديد من التعبيرات اليوحناوية (ولكن يُرجّح أن هذا يعود إلى تأثير يوحنا )؛† وكذلك إلى الأدب المندائي لطائفة لا تزال باقية في العراق حتى يومنا هذا. البطل المخلص في هذه الديانة هو كائن إلهي يُدعى ماندا دايي (معرفة الحياة)، يُرسل من السماء لمحاربة قوى الظلام، ويرتفع منتصرًا “إلى عالم النور والالتقاء بالحياة العظيمة وكل المجتمع السماوي”.13 ويتم التنشئة بالمعمودية، ويحتل يوحنا المعمدان مكانة مرموقة في منظومة الفكر.
ومن ثم يُقال ( أ ) أن تفسير يوحنا لموت وقيامة يسوع مشتق من جماعة معمدانية (مثل التي نجدها في أفسس في أعمال الرسل 19: 1-7)؛ و(ب) أن هذا هو أصل لغة النزول والصعود، وهي لغة غريبة عن الفكر اليهودي. ويؤكد كوميل أن هذا يجبرنا على البحث عن أصول أفكار يوحنا في بعض المصادر مثل الغنوصية المندائية. وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، وعلى الرغم من وجود بعض الأدلة على وجود جماعات معمدانية في سوريا في هذا الوقت، والتي اشتُقت منها المندائية ، فمن المؤكد تقريبًا أن العناصر الغنوصية ترجع إلى التوفيقية اللاحقة. 14 وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، فمن المعترف به بالطبع أن الصعود أمر طبيعي في نهاية العالم، بحيث يتم تصوير تمجيد يسوع من حيث صعود ابن الإنسان (دانيال 7: 13). من ناحية أخرى، ثمة أصل يهودي لمفهوم النزول في تقليد الحكمة الذي سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بالكلمة (ص 13 أعلاه). إن ارتباط النزول والصعود هو تطور مسيحي داخلي، ناتج عن تطبيق فكرتين بالغتي الأهمية في اليهودية على المسيح، لم تجتمعا من قبل. ويمكن توثيقه في أجزاء من العهد الجديد سبقت استخدام يوحنا لهاتين الفكرتين: نجده في ترنيمة ما قبل بولس في فيلبي 2: 5-11، وفي رسالة بولس الثانية إلى بولس في أفسس 4: 1-16، وخاصةً الآية 9 (قارن أيضًا كولوسي 1: 15-20). ويُظهر بولس نفسه هذا التطور باستخدامه فكرة إرسال ابن الله (رومية 8: 3؛ غلاطية 4: 4). هذه ليست الفكرة الغنوصية عن النزول عبر القوى الكونية، بل هي الفكرة الكتابية الأصيلة عن تحقيق خطة الله وغايته المحددة مسبقًا في شخص يسوع. يستخدم يوحنا كثيرًا فكرة الإرسال (3: 17، 34؛ 5: 24، 36 وما يليها، إلخ).15
بما أن يوحنا يستخدم بلا شك آيات العهد القديم الرئيسية لفكرة نزول الحكمة وفكرة صعود ابن الإنسان في سفر الرؤيا، فمن المرجح تمامًا أنه يبني على أفكار مسيحية سائدة لا على نظام فكري غريب. وهنا أيضًا، يبدو أن يوحنا يكتب انطلاقًا من خلفية مسيحية ويهودية، لكنه يستخدم تعبيرات تجذب العالم الأوسع للباحثين الهلنستيين عن الحقيقة داخل المجتمع المسيحي.
5. التاريخ والمكان
لقد ثبت بالفعل في التعامل مع الخلفية المسيحية واليهودية أن التاريخ الأكثر احتمالاً للتأليف هو حوالي 85-95 م؛ في الواقع، فإن العملية، التي تنطوي على طبعتين على الأقل، ربما امتدت طوال هذا الوقت. من ناحية أخرى، فإن عدم وجود أي إشارات إلى الإنجيل في رسائل إغناطيوس وبوليكاربوس (حوالي 115 م) قد يشير إلى أنه لم يُكتب إلا بعد ذلك بكثير. يبدو أن بوليكارب (vii. I) مشتق من 1يوحنا 4. 2 وما يليه، ولكن ليس كما لو كان اقتباسًا واعيًا. ومع ذلك، يدعي إيريناوس (رسالة إلى فلورينوس) أنه كان لديه معرفة شخصية ببوليكاربوس، الذي “سيتحدث عن علاقاته الودية مع يوحنا، ومع بقية أولئك الذين رأوا الرب”. ولكن هذا مهم فقط إذا كان قد تم نسب الإنجيل إلى يوحنا قبل أن يكتب بوليكاربوس رسالته، أي قبل ثلاثين عامًا على الأقل من معرفة إيريناوس به. كل ما يمكننا قوله هو أنه قبل عام 115 م لم يكن الإنجيل منتشرًا على نطاق واسع أو مقبولًا على نطاق واسع ككتابة رسولية. لكن انتشاره كان قد بدأ بالفعل، لأننا سرعان ما وجدنا أنه كان يتم نسخه في مصر. بردية جون رايلاندز (P52)، التي تضم يوحنا 18: 31-4، 37-8، هي أقدم مخطوطة معروفة للعهد الجديد؛ يعتقد آلاند أنها كتبت بحلول عام 130 م على أبعد تقدير. كما أن بردية بودمر (P66)، التي يرجع تاريخها عمومًا إلى حوالي عام 200 م، وضعها هانجر قبل ذلك بخمسين عامًا. مرة أخرى، فإن قطعة الإنجيل غير القانونية (بردية إيجرتون 2) تستند بالتأكيد إلى يوحنا 5؛ 16 نظرًا لأنه يبدو أنه قد كتب قبل عام 150 م، فمن الواضح أن الإنجيل الرابع كان متداولًا لفترة كافية بحيث تستند إليه أعمال أخرى.
المكان التقليدي للتأليف هو أفسس. وهذا له عدة نقاط لصالحه: ( أ ) يبدو أن هناك نوعًا من الصلة بين سفر الرؤيا وبقية أدب يوحنا مؤكدًا، على الرغم من أنه لا يمكن أن يكونا من نفس المؤلفين؛ ورؤيا 1: 9، 11؛ 2:1 يشير إلى أفسس كموطن سفر الرؤيا. (ب) على الرغم من أنهم لا يعرفون الإنجيل الرابع، فإن إغناطيوس وبوليكاربوس يرددان أسلوبه اللغوي، مما يشير إلى آسيا الصغرى، حيث كتبت رسائلهما. (ج) ازدهرت الطوائف الهلنستية في آسيا، وكانت هناك جماعة معمدانية في أفسس (أع 19: 1-7)، (د) كان في أفسس مجتمع يهودي كبير ومهم (أع 18: 19، 24-28؛ 19: 8-20).
القضية ليست قوية على الإطلاق، ولذلك تم اقتراح أماكن أخرى: ( i ) الإسكندرية، بسبب اكتشافات البردي في مصر، وبسبب عقيدة الكلمة لفيلو. ولكن جميع المخطوطات الأكثر قدماً للعهد الجديد تأتي من مصر، وذلك بفضل مناخها الحافظ، وعدم معرفة يوحنا بفيلو في الواقع يمنع الإسكندرية من الاعتبار. (ii) أنطاكية، أو في أي مكان آخر في سوريا، لأنها (أ) قريبة من فلسطين، التي يعرف يوحنا لغتها وعاداتها جيدًا؛ (ب) كان إغناطيوس أسقف أنطاكية؛ (ج) ازدهرت الغنوصية ما قبل المسيحية التي تكمن وراء المندائية في سوريا؛ (د) كان أول تعليق غير هرطوقي من قبل ثيوفيلس الأنطاكي. ولكن الفالنتينيين. كانوا يستخدمون يوحنا في مصر قبل أن يكتب ثيوفيلس تعليقه؛ ربما تكون الغنوصية ما قبل المسيحية غير ذات صلة؛ والنقطتان الأخريان ليستا حاسمتين. لكن سوريا ليست مستحيلة البتة كمكان أصلي. (iii) أما فلسطين نفسها، فرغم جاذبيتها بالنظر إلى الجوانب اليهودية القوية في شخصية يوحنا، إلا أنها غير ممكنة، إذ ازداد المجتمع المسيحي هناك عزلةً بعد الحرب اليهودية، وانفصل عن اليهود، وانقطع عن التطور الرئيسي لكنيسة الأمم. ومن الصعب تصديق أن يوحنا، بعلمه المسيحي المتقدم وفهمه الواسع للأهداف الدينية الهلنستية، كان ينتمي إلى هذه المجموعة. لذا، يقع الاختيار بين أفسس وسوريا، ولكن لا يوجد يقين في هذا الشأن.
6. لغة يوحنا
يمكن تفسير ارتباط يوحنا بفلسطين، والذي يبدو أنه يقتضيه أهمية الخلفية اليهودية، باعتماد يوحنا على عمل أقدم بكثير، ربما من أصل آرامي. تكلم يسوع الآرامية، ويخبرنا بابياس أن متى “رتب الأقوال باللهجة العبرية [أي الآرامية]”،17 مما قد يكون إشارة إلى الأصل الآرامي المفترض – لمصدرالأقوال Q.
كان هناك نقاش حيوي حول لغة الإنجيل الرابع.18 جادل بيرني19 من خلال بناء جملة الإنجيل بأن العمل بأكمله هو ترجمة من أصل آرامي. وقد طعن كولويل20 وبونسيرفن 21 في استنتاجاته، حيث أظهرا أن اللغة اليونانية المشتركة في زمن العهد الجديد تحتوي على جميع النقاط الرئيسية في بناء الجملة التي اعتبرها بيرني آرامية. وترى أحدث دراسة لـ م. بلاك22 أنه بما أن معظم الآرامية موجودة في أقوال يسوع، فإن يوحنا كان يستخدم مصادر آرامية، على الرغم من أنه كتب باللغة اليونانية. ومع ذلك، فإن الآرامية قريبة جدًا من السطح، لدرجة أن بعض الاختلافات في نقل النص اليوناني يمكن إرجاعها إلى ترجمات بديلة لنفس الأصل الآرامي. ولكن مثل هذه الحالات قليلة، حتى أنها تتضمن أمثلة أخرى وجدها بواسمارد، ولا يوجد منها ما هو قاطع. تتم مناقشة أهم الحالات في التفسير.
في الواقع، كتب يوحنا يونانية جيدة، وإن لم تكن أنيقة. بعض مصادره تعود بلا شك إلى أصول آرامية، ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أن أيًا منها كان لا يزال مكتوبًا بالآرامية. وحيثما تتفق لفظيًا مع الأناجيل الإزائية (راجع ص 7 أعلاه)، فلا بد أنها كانت مكتوبة باليونانية. ولكن من المحتمل أن اليونانية لم تكن لغة يوحنا الأم، لذا فإن استخدامه لها كان محدودًا نوعًا ما. تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:
(أ) مفردات يوحنا محدودة للغاية، وإن كانت كافيةً لهدفه. فهو يستخدم المرادفات للتنويع، ولكنه يميل إلى فعل ذلك دون تمييز بينها (المثال الكلاسيكي هو كلمتا agapan و philein love؛ انظر شرح الآيات 21: 15-17).
(ب) بخلاف اليونانية الكلاسيكية، يستخدم يوحنا أداة الربط (parataxis) (وهي جمل متصلة بـ “و”)، وهي شائعة في العبرية والآرامية، ويستخدم أيضًا أداة الربط (asyndeton) (وهي سمة خاصة بالآرامية). وعندما يستخدم أداة الربط، غالبًا ما تكون oun (= لذلك)، ولكنها خالية من معناها الاستدلالي، بحيث تعني فقط “التالي”، أو “ثم”، أو حتى (في 9: 18) “لكن” (انظر أيضًا اليونانية في 12: 1-3).
(ج) كثيرًا ما يستخدم يوحنا صفة الإشارة ekeinos ضميرًا (“هو”)، بينما تُستخدم houtos بهذا الشكل أكثر شيوعًا في اليونانية العادية. ولكن يبدو أن استخدام الضمير بعد اسم قريب يتوافق معه (مثلًا: ١: ٢٧، ٣٣) مُشتق دائمًا من مصادر ذات أساس سامي.
(د) الجمل التفسيرية التي تحتوي على حرفي “هينا” و “هوتي” (الذين) شائعة جدًا، والحرفان متبادلان تقريبًا. تُدخل حرف “هينا” جملةً أخيرةً بشكلٍ صحيح، لكن المعنى غالبًا ما يكون غائبًا في إنجيل يوحنا. وقد فُسِّر هذا على أنه ترجمة خاطئة لحرف “د” الآرامي، الذي يحمل معانٍ واسعة. ولكن من غير المرجح أن يختار المترجم الترجمة الخاطئة، عندما يسمح الحرف بهذا القدر من الحرية. تُستخدم هذه الحروف العطفية، ليس بشكلٍ خاطئ، بل بشكلٍ فضفاض، وبمعنى ضعيف.
(هـ) تبدو أزمنة الأفعال (المضارع التاريخي؛ الطرق التعبيرية للحاضر والماضي الناقص) مشابهةً لبنية الفاعل الآرامية، لكنها شائعةٌ في صيغة الكوينية. أحيانًا، يُمثل الاسم المقارب في صيغة الجر بنية المصدر المطلقة العبرية (وليس الآرامية) (انظر 3. 29)، ولكن هذا يعود إلى التقاليد السامية الكامنة.23
يبدو من المرجح أن اليونانية لم تكن لغة يوحنا الأولى، وأنه تعلمها متأخرًا جدًا بحيث لم يسمح له بإتقانها تمامًا. وهذا يُعيد الثقة في تواصله مع التقاليد القديمة والأصيلة، مع أنه يكتب في أواخر القرن الأول، آخذًا في الاعتبار التطورات المعاصرة. علاوة على ذلك، فإن توزيع السمات اللغوية يشمل الإنجيل بأكمله. وهذا يُضعف نظرية تعدد المصادر المكتوبة، التي ربما كان بعضها باللغة الآرامية، بل يُشير إلى أن الكتابة والتحرير وإعادة الصياغة كلها من عمل رجل واحد.
إن الاختلافات التي لاحظها (على سبيل المثال شفايتزر) بين اللغة اليونانية للسرد والخطابات ربما لا تكون أكثر من أمر لا مفر منه في التعامل مع أنواع مختلفة من الموضوعات.
7. صناعة الإنجيل الرابع
على الرغم من اتساق لغة وأسلوب إنجيل يوحنا بشكل ملحوظ، مما يوحي بأنه عمل رجل واحد، إلا أن هناك انتقالات مفاجئة وتشوهات واضحة، مما يجعل من المستحيل اعتباره مكتوبًا بالكامل في قطعة واحدة. إما أنه تعرض لتغييرات كبيرة أثناء عملية التأليف، أو أنه عانى من تشويش في مرحلة مبكرة. طُرحت نظريات مختلفة، ليست بالضرورة متنافية، لتفسير ذلك: أن يوحنا كان يحرر (ليس بنجاح تام) المصادر المكتوبة؛ أو أن عمليات إزاحة عرضية حدثت؛ أو أن إضافة مواد تكميلية في الطبعات المتتالية أخلَّت بالخطة الأصلية. سيُجادل لاحقًا بأن الحل الثالث هو الأكثر إرضاءً، وأن الإنجيل نشأ في عظات ألقاها يوحنا، والتي استخدمها كأساس لعمله.
1. مسألة المصادر
لُوحظ منذ زمن طويل أن ترقيم الآيات في ٢: ١١ و٤: ٥٤ يشير إلى مجموعة من هذه القصص، استقى منها يوحنا مادته السردية. كان مصدر آيات هذا ليُشكل مجموعة أشبه بالأناجيل الإزائية. لو كان مصدرًا مكتوبًا، فلا يُمكن إعادة صياغته إلا بافتراض أن يوحنا قد نقل مقتطفات منه حرفيًا تقريبًا (كما قال بولتمان ).† على أي حال، يبدو أن يوحنا قد استعار منه خاصية الترقيم في البداية، لكنه سرعان ما تخلى عنها.
لم يُرتَّب الإنجيل حسب العلامات، بل حسب الأعياد اليهودية، حيث يُؤتى بيسوع مرارًا وتكرارًا إلى أورشليم. هذا الترتيب يوحي بعمل تحريري لفرض نمط على مادة غير واضحة المعالم. في هذه الحالة، يمكن التفكير في مصدر للخطاب الذي تم ربطه مع الآيات المختارة من المصدر الآخر، وترتيبها تحت عنوان الأعياد.
يُعد بولتمان أبرز دعاة هذه النظرية. ينبع عمله من نجاح نقد مصادر الأناجيل الإزائية، ولكنه يُمثل أيضًا تطبيقًا رائعًا لأفكار مدرسة تاريخ الأديان، التي كانت مؤثرة في عشرينيات القرن العشرين. يعتبر بولتمان أن مصدر الخطاب هو القصائد الآرامية (مثل المقدمة)، التي تتضمن وحي الرجل السماوي، كاشف أسطورة المخلص الغنوصي (انظر أعلاه، ص 14). وقد قام مترجم يوناني بإضفاء طابع مسيحي عليها بتعريف الكاشف بيسوع التاريخي. تحتوي هذه القصائد على عقيدة يوحنا الحقيقية، والتي لم تُمثل تمثيلًا حقيقيًا في مصدر الآيات أو في قصة الآلام.
لكن تحليل المصدر من هذا النوع قابل للاعتراضات. ( i ) أظهر شفايتزر وروكستول وآخرون أن نمط يوحنا وأسلوبه اللغوي يتخللان العمل بأكمله. لا يمكن استخدام أسلوب المقص واللصق في نقد المصدر مع يوحنا. (ii) لا يقتصر تقليد النمط الإزائي على الآيات، بل يظهر في أقوال يسوع في الخطابات، وهي بالغة الأهمية بحيث لا يمكن إحالتها إلى مرتبة ثانوية. (iii) ترتبط بعض الآيات والخطابات ارتباطًا وثيقًا لدرجة أنه يجب اعتبار الآيات مصدرًا للخطابات، التي بُنيت من مواضيع اكتشفها الإنجيلي فيها (مثل الفصلين 9 و11).24
يجب أن يسير أي نهج سليم في تناول مسألة المصادر على نهج نقد الأناجيل الإزائية. هذا لا يعني أن يوحنا مُحرِّرٌ للمصادر المكتوبة؛ ولكنه بالتأكيد استخدم بعض الأعمال المكتوبة والتقاليد الشفهية بشكل ثابت إلى حد ما. وقد وضع سي إتش دود الخطوط الصحيحة في كتابه “التقليد التاريخي في الإنجيل الرابع”. هنا، يُظهر العديد من الأقوال والتفاصيل السردية توازيًا مع عناصر الأناجيل الإزائية، ولكنها مستقلة عنها. ومن خلال هذه المقارنات، يمكن الكشف عن المزيد من العناصر غير الإزائية من المواد التقليدية. ومن أهداف هذا التعليق لفت الانتباه إلى هذه المواد المبكرة في إنجيل يوحنا. وهنا، يمكن ذكر نقطتين فقط.
( أ ) كان لدى يوحنا مجموعات مكتوبة قصيرة تُشابه إلى حد كبير مصادر الأناجيل الإزائية. وهكذا، تُظهر التفاصيل في الأصحاحات ٢ و٣ و٥ معرفةً بالتسلسل في مرقس ٢: ١-٣: ٦، المعروف بكونه مجموعةً مستقلةً قبل مرقس .٢٥ أما الأصحاحات من يوحنا ٦: ١-٢١ (إطعام الجموع) فتتشابه مع كلٍّ من مرقس ٦ و٨، ولكنها لا تعتمد على أيٍّ منهما. في الأصحاحين ١١ و١٢ (مريم ومرثا)، ٢٠ و٢١ (القيامة)، يستخدم يوحنا مصادر استخدمها أيضًا لوقا، الذي ربما كتب في وقتٍ لاحقٍ بعد يوحنا.٢٦ ومن المرجح أيضًا أن رواية يوحنا عن آلام المسيح مأخوذة من مصدرٍ مكتوب.
(ب) لأقوال يسوع الإزائية مكانةٌ أهم بكثير في بنية الإنجيل مما كان معروفًا سابقًا.27 فهي أبعد ما تكون عن كونها عرضيةً في الخطابات، بل غالبًا ما تكون نقطة انطلاقٍ للحجة بأكملها. وكثيرًا ما يلفت يوحنا الانتباه إلى ذلك بصيغة “الحق الحق أقول لكم”، وهي ليست مجرد أسلوب؛ بل تشير في أغلب الأحيان إلى استخدام قولٍ تقليدي (انظر 1. 51؛ 3. 3، 5، 11؛ 5. 19، 24 وما يليها؛ 6. 26، 32، 47، 53؛ 8. 34، 51، 58؛ 10. 1، 7؛ 12. 24؛ 13. 16، 20 وما يليها، 38؛ 14. 12؛ 16. 20، 23؛ 21. 18).
2. الإزاحات
أيًا كان ما نعتقده بشأن مصادر يوحنا، لا يزال يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا علامات الاقتلاع في الإنجيل كما وصلت إلينا. حشد برنارد الأدلة لإظهار أن الإزاحة العرضية لكتل كاملة من المواد يمكن أن يكون بسبب اختلال ترتيب بعض أوراق المخطوطة، بافتراض أن كل كتلة ستملأ ورقة واحدة أو أكثر بالضبط. لم تحظ هذه النظرية بقبول واسع، وتم تجاهلها في التحليل الحاسوبي لماكجريجور ومورتون.28 إلى حد ما، تم تخفيف آثار الإزاحة، بحيث يلزم شيء آخر الحدوث العرضي. ومن هنا جاءت فرضية “السكرتير”، التي تفترض أن المحرر النهائي قد حاول دون جدوى تجميع المادة التي كانت في شكل ملاحظات فوضوية تمامًا. تُعدّ نظرية من هذا النوع أساسيةً لبولتمان، إذ يرى أن القصائد الغنوصية الأصلية المسيحية، والتي تُشكّل نواة الخطابات، لا يُمكن استعادتها إلا بتقطيع المادة الموجودة وإعادة تجميعها، وذلك لجمع أغشية التراكيب الموضوعية. disjecta membra وبالتالي، لا تُعتبر السمة اليوحناوية النموذجية من الإحالات المتقاطعة والتكرار جزءًا أصيلًا من التصميم الأصلي. وتتمثل الاقتراحات الرئيسية فيما يلي:
(أ) نُقلت الفقرات 3. 22-30 لتلي الفقرات 3. 36 (برنارد)، أو 2. 12 (موفات). هذا يجمع الفقرات 3. 13-21 و3. 31-6، وهما وثيقتا الصلة. رتب شناكنبورغ ، متبوعًا بلانك، الفقرات بالترتيب 3. 31-6، 13-21، معتبرًا إياها إضافات متأخرة لمواد أصلية.
(ب) نُقل الفصل السادس ليسبق الفصل الخامس، لأن الفقرة 7. 23 تُشير إلى 5. 1-18. وبدلًا من ذلك، نُزعت الفقرات 7. 15-24 من سياقها ووُضعت بعد 5. 47.
(ج) أُعيد ترتيب الإصحاح العاشر، لأن قصة الراعي الرمزية أُعيد تناولها في مناسبة لاحقة، والجزء السابق منها يُفسد الإحالة إلى الإصحاح التاسع. لذا، الترتيب المقترح هو ١٠: ١٩-٢١، ٢٢-٩، ١-١٨، ٣٠-٩. لكن هذا مُستحيلٌ حقًّا، لأنه لا يُقدم أي تفسير “للانقسام بين اليهود” (الآية ١٩) إذا لم تُقدَّم القصة الرمزية بعد؛ فالآيات ٢٦-٩ لا يُمكن أن تسبق القصة الرمزية، لأنها تفترض نتائج ما يُبنى ببطء ومنهجية خلالها؛ وتُشكِّل القصة الرمزية انتقالًا من موضوع البصر والعمى في الإصحاح التاسع (المُطبَّق الآن على الرعاة الحقيقيين والكذبة) إلى لاهوت الآلام الذي يبدأ بملاحظة مناسبة جديدة في الآية ٢٢.
(د) تم وضع 12. 44-50 (مع دعم جزئي من دياتيسارون تاتيان) بعد 12. 36أ، وبالتالي جمع أقوال يسوع معًا قبل تعليقات الإنجيلي.
(هـ) يُعيد برنارد ترتيب أحاديث العشاء على النحو التالي: ١٣: ١-٣٠؛ ١٥: ١-١٦: ٣٣؛ ١٣: ٣١-٨؛ ١٤؛ ١٧. لدى بولتمان تسلسل مشابه، ولكنه أكثر تعقيدًا. الهدف هو اختتام عبارة “انهض، لننطلق من هنا” في ١٤: ٣١، وتخفيف التناقض الظاهر بين ١٣: ٣٦ و١٦: ٥. هذا الترتيب يُفسد تعليم الباراكليت، الذي يجب أن يبدأ بـ ١٤: ١٦. لكن شناكنبورغ، مرة أخرى، يعتبر مقاطع الباراكليت إضافات لاحقة لمواد أصلية.
(و) يُعيد سبيتا ترتيب الآيات ١٨: ١٣-٢٨ ليتناسب مع ذكر رئيسَي الكهنة، حنان وقيافا. ويحظى تسلسله المقترح (١٨: ١٣، ١٩-٢٤، ١٤-١٨، ٢٥ب-٢٨-٢٥أ، تكرار تحريري للآية ١٨) ببعض الدعم من السينائية السريانية ، وإن كان ذلك يُعزى على الأرجح إلى الرغبة في التقارب مع ترتيب الأناجيل الإزائية.
سيتم النظر في إعادة الترتيبات الجديدة هذه في سياق الشرح. جميعها قابلة للاعتراضات؛ في الواقع، لم يكن بعضها ليُطرح لو فُهمت أساليب يوحنا في التأليف بشكل صحيح. من أساليبه الاحتفاظ بجزء من مادة أحد المقاطع لتشكيل نواة المقطع التالي. ينطبق هذا على الفقرات 7. 15-24 و10. 26-29 (انظر (ب) و(ج) أعلاه)، ويمكن تفسير موضع الفقرات 3. 31-36 في (أ) بشكل مشابه. أما البعض الآخر، فيُفسر بشكل أفضل بأنه يعود إلى إدخال يوحنا نفسه مواد تكميلية، حيث وسّع عمله الأصلي بشكل كبير.
3. المواد التكميلية
من المناسب اعتبار الكتل التالية إضافاتٍ للطبعة الثانية من الإنجيل، مع أنها لم تُضَف جميعها بالضرورة في الوقت نفسه. وستُقدَّم حججٌ مُفصَّلةٌ لاعتبارها إضافاتٍ في الشرح.
( أ ) تم استبدال المقدمة (١: ١-١٨) مكان المقدمة الأصلية التي بدأت بيوحنا المعمدان، كما في مرقس. وتنتمي الآيات ٦-٨ و١٥ إلى هذه المقدمة الأصلية.
(ii) من الواضح أن الفصل السادس وحدة مستقلة. 29 مع أن الخطاب يُفترض أنه شرح لمعجزة الإطعام، إلا أنه في الواقع جزءٌ مُستدام من التفسير الكتابي. وقد أدرجه يوحنا بعد 5: 47 كمثال على ادعاء يسوع أن موسى “كتب عني” (5: 46). لم يُلاحظ المفسرون هذه الحقيقة عمومًا.
(iii) أُضيفت مادة لعازر (11. 1-46؛ 12. 9-11) للتحضير لآلام يسوع. هذا لا يكسر الصلة بين الفصلين 10 و12 فحسب، بل دفع يوحنا أيضًا إلى إجراء المزيد من عمليات إعادة الترتيب للطبعة الثانية. سيُجادل في التعليق أنه في طبعته الأصلية كان لديه ترتيب للأحداث أقرب إلى ترتيب الأناجيل الإزائية، بما في ذلك الدخول المنتصر (12. 12-19)، وتطهير الهيكل (2. 13-22)، ومؤامرة الكهنة (11. 47-53)، والمسح في بيت عنيا (12. 1-8). لقد أزال يوحنا التطهير إلى الإصحاح 2 من أجل جعل إقامة لعازر الدافع الرئيسي لمؤامرة الكهنة، وجعل المسح في علاقة أوثق مع مادة لعازر. في الأصل كان له ارتباط أكثر وضوحًا بالعشاء الأخير (الفصل 13).
(د) أفضل تفسير لـ “قوموا، لننطلق من هنا” في ١٤: ٣١ هو أن الإصحاح ١٤ فقط ينتمي إلى الطبعة الأولى. الإصحاحان ١٥ و١٦ هما خطابان إضافيان أُضيفا في الطبعة الثانية (أُضيفت مقاطع الباراقليط إلى الإصحاح ١٤ في الوقت نفسه). من المرجح أن صلاة الإصحاح ١٧ تنتمي أيضًا إلى الطبعة الثانية، لذا لم يكن هناك انقطاع في الأصل بين ١٤: ٣١ و١٨: ١.
لاستعادة الخطة الأصلية للإنجيل، لا يكفي حذف هذه الإضافات وإجراء التعديلات اللازمة على الفصلين الثاني والثاني عشر، بل يجب أيضًا حذف الإضافات التي تلت يوحنا. هذه الإضافات هي فقرة الزنا (٧: ٥٣-٨: ١١)، التي لم تُدرج في تراث المخطوطات إلا بعد كتابة الإنجيل بوقت طويل؛ والملحق (الفصل ٢١)، الذي يُحتمل أنه يُجسد عمل الإنجيلي نفسه في الآيات ١-٢٣، ولكن أحد المحررين أضافها ربما بعد وفاته؛ وكل أو جزء من الآية ١٩: ٣٥. تبرز الحجة المسيحية الرئيسية للكتاب، التي تبدأ (١: ١٩-٣٤) وتنتهي (١٠: ٤٠-٢) بشهادة يوحنا المعمدان، بوضوح تام، قبل مقدمة قصة الآلام وأحداثها التقليدية في الفصل ١٢.
4. عظات يوحنا
تشير تقنية يوحنا في نقل المادة من قسم إلى آخر (أعلاه، ص 18) إلى أنه استخدم قطعًا كبيرة ومستقلّة كأساس لعمله، مجزّئًا إياها إلى حدّ ما في عملية بناء سرد مترابط. من المرجح جدًا أن معظم هذه القطع الأساسية كانت عظات ألقاها على الجماعة المسيحية، ربما في القربان المقدس. ومن الواضح أن الفصل السادس يناسب هذا السياق. ومن المرجح أن بعض القطع قد أُلفت خصيصًا للإنجيل، الذي لا يقتصر على عظات مترابطة. غالبًا ما تتضمن هذه القطع أجزاءً من عظات غير مستخدمة بكاملها (مثل مقاطع المعزي في خطب العشاء، وانظر تحليل الفصل السابع في التعليق).
هناك اعتراضان رئيسيان على هذه النظرية: ( أ ) إن الكثير من كتابات يوحنا، حتى في الخطابات، هي في شكل حوار، بحيث تبدو وكأنها سجل للمناظرات بدلاً من العظات. (ب) إن المحتوى يهتم إلى حد كبير بقضايا الجدل اليهودي والمسيحي، في حين أن العظات من المرجح أن تكون موجهة إلى تنوير المؤمنين. فيما يتعلق بالنقطة الأولى، لا يمكن افتراض أن يوحنا قد قدم تقارير حرفية عن المناظرات الفعلية (على الرغم من أن ج. لويس مارتن يرى أن مثل هذه المناظرات تنعكس في تاريخه وعلم اللاهوت في إنجيل يوحنا (1968)، ص 26 وما يليه). لا يوجد سبب يمنع يوحنا من تبني أسلوب “سرد قصة ” عن يسوع في إلقاء عظاته. المناظرات هي ببساطة جزء من القصة. النقطة الثانية تفترض تمييزًا صارمًا للغاية بين الجمعية الليتورجية وغرفة المناقشة. لم يكن من الممكن ابتكار أسلوبٍ أفضل للتنوير من هذه المؤلفات المُلهمة، التي تُجسّد النقاطَ التي تُثير اهتمامًا بالغًا لدى مجموعةٍ من المسيحيين الذين هم على تماسٍّ وثيقٍ باليهودية. على أي حال، وكما أُشيرَ آنفًا، كان على يوحنا أن يُكيّف عظاته وأن يُؤلّف قدرًا من المواد الجديدة لكتابة الإنجيل.
لقد اكتسبت هذه النظرة الوعظية إلى صناعة الإنجيل الرابع أرضية في النقد الأخير (قارن باريت، براون، براون، شناكينبورج، ساندرز)، ولكن لا بد من إثباتها من خلال فحص أسلوب يوحنا. مثال واحد يكفي لإظهار أسلوبه الأدبي وأساسه الوعظي: الفصل الخامس، والذي يجب أن يتضمن بالطبع 7: 15-24.
الآية 5. 1 هي ملاحظة تحريرية للحفاظ على تسلسل السرد، وتبدأ العظة عند الآية 2. وتتكون من علامة افتتاحية (2-9أ)، وحوار انتقالي (9ب-18)، والخطاب (19-47)، وحوار ختامي (7. 15-24).
(أ) الآية هي شفاء رجل مشلول، مستمدة من مجموعة روايات يوحنا عن يسوع. سيتضح في الشرح أنها مزيج من تقليد أورشليمي غير الإزائي وقصة الجليل الشهيرة في مرقس ٢: ١-١٢. وهكذا، وبصفته واعظًا خبيرًا، يبدأ يوحنا بقصة لإثارة اهتمام سامعيه؛ ومثل العديد من المعلمين المسيحيين الذين أعادوا سرد قصص يسوع في تعليمهم، دمج دون وعي روايتين مختلفتين.
(ب) عليه بعد ذلك أن يدور حول الموضوع ليُفضي إلى المسائل الجادة التي يرغب حقًا في تعليمها. يتم ذلك من خلال حوار 9ب-18، والذي يُشابهه في حوار 9: 13-41. في كلتا الحالتين، تُربط مسألة السبت جزافًا بتقليد لم يكن لها فيه أي دور في الأصل؛ علاوة على ذلك، في كلتا الحالتين، يسمح غياب يسوع عند بدء الحوار بتوضيح شروط الحجة قبل الوصول إلى العبارة الأساسية (5: 17 يُمهّد الطريق للآية 19). الوصف محدود ومُصطنع، والفقرة مُخصصة في الواقع لعملية التفكير؛ وربما تكون مُصطنعة تمامًا. سيتذكر العديد من الوعاظ الالتواءات اللازمة للانتقال من نص مُعطى إلى النقطة الحقيقية محل النقاش.
(ج) الخطاب لا يعتمد في الواقع على الآية، بل له نصه الخاص في شكل مثل نابع من تقاليد غير إزائية لكلمات يسوع (انظر التعليق على الآيات 19-20أ). وعلى الرغم من أنه يمكن تمييز مواد تقليدية أخرى في الآيات 24 و30 و32-6، فإن النص بأكمله هو في الحقيقة تأليف يوحنا في شكل خطاب ليسوع نفسه. قد يرى البعض أن يوحنا مخطئ أخلاقياً بفعله هذا، ولكن يجب تفسير ذلك ببساطة على أنه أسلوبه في الوعظ. إنه يستخدم أسلوب المونولوج الدرامي؛ ويعرف جميع الوعاظ مدى جاذبية هذا الأسلوب – إنه أسلوب يمكن توضيحه من الأعمال الوعظية المسيحية على مر العصور، على سبيل المثال توماس أكيمبيس في القرن الرابع عشر و بنسون RM Benson في القرن التاسع عشر. يشعر الواعظ أنه يمتلك عقل المسيح (راجع 1 كو 2: 1-16)، وأن ما يقوله هو امتداد مشروع لتعليمه. من المرجح أن يوحنا كان يُعتبر نبيًا لدى إخوانه رجال الكنيسة (راجع 1 كو 14: 1-5).
(د) الحوار الختامي في 7: 16-24 (الآية 15 رابط تحريري) ليس نهاية العظة بقدر ما هو مادة إضافية منها. يُظهر أسلوبًا مميزًا آخر ليوحنا، وهو العودة إلى بداية الحجة عند كل قسم جديد (وبالتالي، فإن 5: 30 و7: 16 يعودان إلى 5: 19).
بشكل عام، يمكن القول أن يوحنا يُظهر شعورًا قويًا بالدراما، ولكن هذا يظهر في الخطابات أكثر من السرد. إنه يعرف كيف يرتب مادته لتؤدي إلى ذروة مثيرة للإعجاب. إنه أستاذ معترف به في فن السخرية الدرامية، ولكن هذا يوجد في العبارات المتناقضة كما يوجد في المواقف. المثال الأكثر شهرة هو موضوع الملكية في المحاكمة أمام بيلاطس (18: 33-8؛ 19: 1-16). للحصول على أمثلة أخرى، انظر 1: 9-13؛ 2: 19؛ 3: 10؛ 4: 11، 19، 33؛ 5: 18، 46؛ 7: 24، 34-6، 41 وما يليها، 52؛ 8: 22، 33، 41، 56 وما يليها؛ 10: 33؛ 11: 12، 16، 48؛ 12: 27؛ ١٣: ٢، ٢١-٣٠، ٣٦؛ ١٥: ٢٥؛ ١٦: ٣، ٣٠؛ ١٨: ٥، ١٤، ٢٨؛ ١٩: ٩ وما يليها، ١٤ وما يليها، ٢١، ٢٨؛ ٢٠: ٢٧، ٢٩. يستخدم يوحنا أيضًا حيلةً مُفضّلةً، وهي جعل سامعي يسوع يُسيئون فهم معناه، وذلك لتوضيح الفرق بين القصد والتعمق في الموضوع (راجع ٣: ٣-٥؛ ٤: ١٠-١٥، ٣٢-٤، إلخ). هذا تمثيلٌ جيد، ولكنه غير مُحتمل في الواقع.
مع ذلك، لا يمتد حس يوحنا الدرامي إلى استكشاف الشخصية. هناك نقص في الدفء الإنساني في صورة يسوع، مما يتطلب استكمال الصورة الإزائية لنقل الحقيقة. الشخصيات الأخرى غالبًا ما تكون مجرد نسخ احتياطية ليسوع؛ بمجرد أن يُثبتوا وجهة نظرهم، يُطردون من المسرح (مثل نيقوديموس في 3: 1-15). محاولات التمييز غير متقنة. بطرس وأندراوس وتوما شخصيات نمطية تُمثل وظائف مختلفة، وينطبق الأمر نفسه على التلميذ الحبيب.
أحد أسباب عدم إرضاء هذه الصورة ليسوع (التي يُطلق عليها ستراثمان “الأسلوبية التبشيرية”) (kerygmatic stylization) ينبع مباشرةً من لاهوت يوحنا. فبعد دخول يسوع في المشورات الإلهية، فهو يعلم كل ما سيحل به، ويتحكم تمامًا في مصيره. لديه بصيرة في الشخصية (٢: ٢٥)، ويعلم أن يهوذا سيخونه (٦: ٧١)، ويؤخر الرد على رسالة عاجلة لأسباب عليا (١١: ١١)، ولا يطلب الضمان الإلهي إلا من أجل الآخرين (١١: ٤٢؛ ١٢: ٣٠)، والأهم من ذلك كله، أنه يعلم متى ستأتي “ساعته” (٢: ٤؛ ٧: ٦، ٣٠؛ ٨: ٢٠؛ ١٢: ٢٧؛ ١٧: ١؛ قارن ١٨: ٤). بهذه الطريقة، يُضيف يوحنا إلى يسوع المصالح الاعتذارية للكنيسة الأولى، والتي تطلبت آلام المسيح، وخاصةً فشل يهوذا، تفسيرًا لها. قُدِّر أن هذه الحقائق المُحرجة كانت جزءًا من خطة الله، المُتنبأ بها في الكتاب المقدس. في الواقع، يُعيد جولين إنتاج بعض المقاطع المُعتادة المُستخدمة في هذا الصدد (مثل ١٩: ٢٤، ٢٨).٣٠ والنتيجة هي أن تصويره ليسوع يميل إلى جعله شخصيةً خارقة. وهذا له تأثيرٌ مؤسف، إذ إن المسيح في الإنجيل الرابع، بعيدًا كل البعد عن كونه مُناهضًا للدوسيتيا، يفتح الباب على مصراعيه أمام ديانة دوسيتية مسيحية، والتي لا شك أن يوحنا نفسه كان سينبذها برعب (راجع الصفحات ٦١ وما بعدها أدناه).
8. القيمة التاريخية للإنجيل الرابع
لا شك أن الملاحظات الأخيرة ستُثير بعض الشك حول قيمة الإنجيل الرابع كوثيقة تاريخية. فقد رأينا في أقسام سابقة أن يوحنا لا يُمكن اعتباره شاهد عيان على الأحداث التي سجّلها، وأنه يكتب بعد وقوعها بوقت طويل. على أي حال، فإن عرضه لها يهيمن عليه هدفه اللاهوتي؛ فقد يكون لديه تقاليد عريقة، لكنه يُعيد صياغتها جذريًا لتناسب تفسيره لمعنى المسيح. لا يُمكن حصر القيمة التاريخية لعمله في مسائل الوقائع التاريخية والأشخاص والأماكن التي يُمكن استعادتها بتجريد تفسيره لكشف التقاليد الأساسية؛ كما لا يكفي الإشارة إلى المعلومات التي يُوحي بها الإنجيل عن حالة الكنيسة في عصره. السؤال ذو الأهمية الحاسمة للقارئ المعاصر هو ما إذا كان تفسير يوحنا ليسوع صحيحًا. مع مراعاة قدرٍ لا مفر منه من التحريف، هل يُمكننا قبول تفسير يوحنا كسردٍ حقيقي لما كان يحدث حقًا عندما عاش يسوع وعمل بين البشر؟
فيما يتعلق بالحقائق، من المشكوك فيه أن يضيف الإنجيل الكثير إلى المعرفة التي لدينا من الأناجيل الإزائية. يجب تصحيح ترتيب الأحداث إلى حد ما لتتوافق معها بشكل أوثق، وعلى أي حال فإن عادة يوحنا في إحضار يسوع إلى أورشليم للأعياد هي أسلوب أدبي أكثر من كونها ذكرى تاريخية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يسوع زار أورشليم بشكل متكرر أكثر مما يشير إليه الإزائيون. من ناحية أخرى، يميل العديد من العلماء إلى اعتبار الملاحظات الموجزة لخدمة يسوع المبكرة في يهودا (3. 22؛ 4. 1) عنصرًا أصيلًا أغفلوه. وفيما يتعلق بالتفاصيل، فإن تقاليد يوحنا الأساسية غير الإزائية لديها الكثير لتقدمه، سواء من الأقوال أو الحوادث، لملء الصورة الإزائية؛ ولكن لا يمكن استردادها إلا من خلال التحليل الدقيق للمادة كما هي.
سبقت الإشارة إلى معلومات عن الكنيسة في زمن يوحنا في القسم المخصص لخلفيته الفكرية، وخاصةً فيما يتعلق بالخلفية اليهودية. تجدر الإشارة هنا إلى أن الفصل التاسع قد أشار إلى سمة يهودية أخرى، وهي إقصاء المسيحيين عن الكنيس. انظر القسم التالي.
فيما يتعلق بتفسير يوحنا للأحداث، لا شك أن يوحنا نفسه كان مقتنعًا تمامًا بصحة عرضه ليسوع – أي كريستولوجيا يسوع -. ويعتمد اتفاقنا معه إلى حد كبير على افتراضاتنا الدينية . تتسم كتابات يوحنا بطابعٍ سلطويٍّ يبدو أنه لا يقبل أي تناقض؛ ولكن لا ينبغي أن ننخدع بهذا لنفترض أن فكره متجانس ومنهجي تمامًا. فهو لا يزال يتخبط إلى حد ما. تقتصر كريستولوجيا الكلمة لديه على المقدمة، وهي جزء من الطبعة الثانية من عمله؛ ونرى في مواضع أخرى دمجًا بين لقب ابن الإنسان، الذي استخدمه يسوع كتسمية ذاتية في التقليد الإزائي، وبين علاقة الآب والابن التي تشهد عليها مخاطبة يسوع لله بـ”الآب” (راجع لوقا ١١: ٢؛ ٢٢: ٤٢). في كثير من الأحيان تكون التصريحات متناقضة لدرجة أنه ليس من الواضح ما إذا كان يوحنا يقصد بعلاقة الآب والابن العلاقة الروحية لأي شخص متدين مع إلهه، أو العلاقة الميتافيزيقية التي تنطبق فقط على المسيح باعتباره الإنسان السماوي. وبالتالي، هناك بعض التصريحات التي لا يمكن إلا أن تبدو شنيعة للعقل اليهودي (راجع 8: 48-59؛ 10: 30-9). هناك لحظات يبدو فيها أنه يناقض نفسه بشكل قاطع – 10: 30: “أنا والآب واحد ” و14: 28: “الآب أعظم مني”. طُرحت أسئلة حول معنى المسيح منذ الأيام الأولى، وكانت نصوص يوحنا المتناقضة موضوعًا للجدل لعدة قرون. لم يتم ابتكار صيغة للطبيعتين في المسيح، الإلهية والبشرية، إلا في مجمع خلقيدونية عام 451 م. من يبني إيمانه على هذا الأساس العقائدي، سيميل حتمًا إلى فهم المسيح اليوحناوي بمصطلحات خلقيدونية، متناسين أن هذا التعريف لم يُصاغ إلا بعد 350 عامًا. إن كون تعبيرات يوحنا غير المتسقة دائمًا قد مهدت الطريق لهذا التعريف، يُظهر الأهمية الجوهرية للإنجيل الرابع في تاريخ الكنيسة.
تكمن القيمة التاريخية لعرض يوحنا للمسيح في أنه شاهدٌ بالغ الدلالة على الآثار طويلة المدى لتأثير المسيح المذهل نفسه. وتشير التناقضات إلى أن فكرته عن معنى يسوع تقع في منتصف الطريق بين التجربة الأصلية للتلاميذ وبدايات نظام فكري رسمي، يتضمن قدرًا من الحقيقة وقدرًا من التشويه. وتبقى الحقيقة أنه لا يزال من الممكن الادعاء، كما حدث مرات عديدة عبر القرون، بأن أحدًا لم يدرك معنى يسوع أفضل من يوحنا. ولا تعتمد أهمية عمله على دقة النقل بقدر ما تعتمد على قدرته الفكرية على اختراق التقاليد وإظهار معناها الداخلي. وإذا كان من الشروط الأساسية لفهم عمل الله الخلاصي أن يعتمد المعنى الإلهي لحدث ما على الحقيقة والتفسير، فإن إنجاز يوحنا الخاص هو أنه قدم الأدلة لتفسير الحقائق .
9. قضايا خاصة
إلى حد ما، يختلف الإنجيل الرابع عن بقية العهد الجديد. لذا، يُمكن القول إن يوحنا لا يعكس قضايا جديدة كانت تطرح في كنيسة عصره فحسب، بل إنه أيضًا يقف خارج التيار السائد للمسيحية، ويعارضه بشدة.
1. تأخير المجيء الثاني
بشّر يسوع بقرب حلول ملكوت الله. وفُسِّر موته وقيامته على أنهما الحدث الحاسم في الانتقال من العصر المنصرم إلى العصر الجديد الآتي. ولكن، وفقًا للتوقعات الرؤيوية، ينبغي أن يتميز هذا الحدث بالقيامة العامة للأموات والدينونة (دانيال ١٢: ١ وما يليه). أكدت الوعظة الأولى للرسل أن يسوع سيظهر قريبًا في المجد ليُعلن ملكوته. لكن الزمن مرّ، ولم يظهر يسوع. مات بعض الذين اعتنقوا المسيحية. يمكننا أن نرى المشكلة التي طرحها هذا في رسالتي تسالونيكي الأولى والقرن الخامس عشر. دون إنكار تام للمشكلة، يُركز بولس على الاستجابة لله في المسيح: إذا كان الإنسان في المسيح، فإن نقطة القرار، أي الدينونة الفعلية، قد ولت بالفعل؛ ولم يعد تأخير المجيء الثاني مهمًا. استُبدلت فكرة الملكوت بمفهوم الوجود في المسيح.
وينطبق الأمر نفسه على يوحنا. فهو لا يُشير قط إلى ملكوت الله، إلا في 3: 3، 5. من ناحية أخرى، يُؤكد مرارًا أن الإيمان بيسوع يفتح الطريق للتمتع ببركات الدهر الآتي. قد يستخدم لغة علم الأخرويات المتسق (“الساعة آتية” (5: 25))، ولكنه يُحددها في السياق نفسه (“وهي الآن”): “لن يُقام المؤمن في اليوم الأخير فحسب” (6: 39، 40، 44)، بل حتى الآن “له حياة أبدية” (6: 47). بل يُمكنه القول إن المؤمن “لن يموت أبدًا” (11: 26). ربما يرتبط مصير التلميذ الحبيب (21: 20-3) بهذه المشكلة: هل سينجو حتى المجيء الثاني؟ الإجابة غير مُرضية؛ يبدو أن يسوع يُحاول التهرب من الإجابة. قد يستنتج المرء أن فكرة المجيء الثاني لا ينبغي أخذها على محمل الجد.
ينكر النقد الحديث أكثر فأكثر إمكانية وجود إسخاتولوجيا مُدركة تمامًا للآخرة. يجب أخذ لغة الإسخاتولوجيا المتسقة في إنجيل يوحنا على محمل الجد؛ قرار بولتمان بحذف مثل هذه المقاطع (مثل 5: 26-9) باعتبارها من عمل المحرر الكنسي – الديني هو قرار تعسفي بحت، ويعتمد على مطابقته لعقيدة يوحنا مع الغنوصية. ولكن، في الحقيقة، فإن النقطة الأساسية هي أن الحدث التاريخي للمسيح يستبق النهاية، ويكشف أيضًا عن كونه القاضي المُعيّن. لذا فإن التمسك بالمسيح يعني أن الدينونة مُتوقعة في حالة المؤمن، وهو يعرف بالفعل شيئًا عن النعيم الأخير. بالنسبة لمثل هذا الشخص، لا يُتوقع المستقبل في الحاضر فحسب، بل إنه مضمون أيضًا في النهاية (راجع 10: 27 وما يليه). ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن الخلاص يكمن في نوع من التصوف الخالد.
ولا يوجد ما يدل على أن يوحنا يعارض عن قصد وجهة نظر مختلفة. فهو يستخدم تعبيرات رؤيوية متناقضة، بحيث تنطبق على الحاضر من خلال التوقع وعلى المستقبل. لكنه لا يضع صراحةً حاضرًا أبديًا في مواجهة إسخاتولوجية مستقبلية؛ ولا يطلب من قرائه التوقف عن الاهتمام بـ”الأزمنة والأزمنة” (1 تسالونيكي 5: 1)، كما لو كان عليه تصحيح أفكار خاطئة. يمكننا القول إن تأخر المجيء الثاني هو تأثير أساسي، يفسر التركيز على التوقع الحاضر للنهاية من خلال الإيمان بالمسيح، بحيث لا يقدم يوحنا “أخلاقًا مؤقتة”، بل تفسيرًا للإنجيل صحيحًا لكل زمان. ولكن لا يوجد ما يدل على أن هذه قضية تفصل يوحنا عن غالبية المسيحيين في عصره.
2. جدل حول الأسرار المقدسة
تنشأ المسألة التالية من الأولى. إذا كانت روحانية يوحنا تُركّز كل التركيز على الاستجابة الداخلية للمؤمن، فيمكن القول إنه يُعارض، ليس فقط الرؤيا الكارثية لكنيسة عصره، بل أيضًا كل مظاهر النظام والعبادة في الكنيسة. يُغفل يوحنا، دون أي تفسير، تأسيس القربان المقدس من روايته للعشاء الأخير (الفصل 13). يستخدم موضوعات القربان المقدس (خبز الحياة (6. 26-58)؛ الكرمة (15. 1-17)، ولكن هذه ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأعمال الليتورجية، ولا تتميز عن الموضوعات الأخرى التي ليس لها أهمية ليتورجية (الماء (4. 7~15)؛ النور (8. 12)؛ الحياة (11. 25 وما يليه)). ينقسم العلماء المعاصرون حول هذه المسألة. لم يكن بولتمان بأي حال من الأحوال أول من رأى سلالة معادية للأسرار المقدسة في يوحنا، ولكن نظريته حول الأصول الغنوصية للخطابات تتطلب ذلك بشكل إيجابي. الموضوعات المذكورة للتو هي جوانب مختلفة من الحقيقة التي جلبها الكاشف، والتي لا تهتم بالممارسات الطقسية ولكن بالتوجه الداخلي للعقل. لا ينكر بولتمان وجود إشارة مباشرة إلى القربان المقدس في 6. 51ب-8، ولكنه ينسب هذه الآيات إلى المحرر الكنسي، الذي كان لديه مصلحة محددة في جعل الإنجيل متوافقًا بالأفكار والممارسات التقليدية. وبالمثل، يعتبر تكليف الرسل بمغفرة الخطايا (٢٠: ٢٣) تقليدًا قديمًا أعاد صياغته الإنجيلي (وهو ليس مثل المحرر الكنسي)، لتطبيقه على الجماعة المسيحية ككل (ص ٦٩٠، ٦٩٣).
تستند النظرية إلى انطباع عام عن الإنجيل، مدعومًا بحجة خطيرة من الصمت. إنها تستلزم استئصالًا من النص المستلم لأسباب عقائدية دون أساس متين من النقد الأدبي. إن موضوعات الماء والنور والحياة، التي هي بالتأكيد مجازية في الديانة الهيلينية العليا، ليست بالضرورة خالية من الأهمية الليتورجية في يد يوحنا، لأنها قد تتضمن إشارة إلى المعمودية. هناك مجال للاختلاف حول المدى الذي ينوي يوحنا تقديم مثل هذه التلميحات. لا شك أن كولمان ونيوالدا يذهبان بعيدًا في رؤية التلميحات الليتورجية في كل مكان. ولكن بينما كانت الأسرار المقدسة ونظام الكنيسة يُعتبران في الماضي إضافات دخيلة على رسالة يسوع الأصلية، تميل الأبحاث الحديثة إلى تأكيد أنهما ينتميان إلى أكثر فروع التقليد بدائية. لقد أعطتنا طائفة قمران فكرة عن كيفية تجسيد طائفة يهودية لمثل هذه المؤسسات، حتى بدون البنية الفوقية للاهوت المسيحي. إذا كانت النظرة الوعظية لتكوين يوحنا صحيحة، فإن الصمت لا يرجع إلى عدم الموافقة ، ولكن إلى حقيقة أن الأسرار والنظام الكنسي مفترضان. لأن العظات كانت تُلقى بالفعل في سياق القربان المقدس. بالنسبة ليوحنا، فإن المؤسسات المسيحية ليست فقط شكل حياة الكنيسة التي تُستقبل من الماضي، ولكنها تحمل علاقة متكاملة بالمعنى الأساسي لحياة وعمل يسوع نفسه. يتم التعبير عن هذا الارتباط في رمزية الكرمة، وفي التعليم عن الاضطهاد الذي يتبعها (الفصل 15). نظرًا لأن هذا الفصل يقع في العشاء الأخير، فمن الطبيعي جدًا أن نرى إشارة إلى خمر القربان المقدس في هذا الرمز. كما هو الحال في القضية الأولى، من غير السليم الشك في جدل لم يُخرج إلى السطح.
3. جدل ضد الطائفة المعمدانية
يُولي الإنجيل الرابع أهميةً خاصة ليوحنا المعمدان باعتباره الشاهد الرئيسي للمسيح (١: ٦-٨، ١٥، ١٩-٣٦؛ ٣: ٢٢-٣٠؛ ٥: ٣٠-٦؛ ١٠: ٤٠ وما يليه). مع أن لهذه المقاطع وظيفةً إيجابيةً في تعزيز مكانة يسوع الفريدة، إلا أنه يُمكن تفسيرها على أنها عدائية، لأنها تُبنى على التباين. يسوع أفضل من المعمدان من جميع النواحي. عندما نجد أن تلاميذ المعمدان يواصلون العمل بطريقةٍ موازيةٍ لتلاميذ يسوع (٣: ٢٢ وما يليه؛ ٤: ١)، يُطرح السؤال: هل يعكس هذا الموقف التنافس بين الجماعات المسيحية والمعمدانية في زمن يوحنا؟
لا شك أن العلاقة بين المعمدان ويسوع كانت بحاجة إلى تفسير في الأيام الأولى للكنيسة؛ راجع متى ١١: ٢-١٩. وكان الموقف النهائي المتخذ هو أن المعمدان كان آخر الأنبياء، وأنه قام بدور إيليا، الذي كان من المتوقع أن يعود ليهيئ الناس ليوم الرب (ملاخي ٤: ٥ وما يليه؛ راجع لوقا ١: ١٣-١٧). ومن المرجح أن وراء هذا التفسير تكمن الحقيقة المحرجة المتمثلة في انفصال يسوع عن المعمدان، الذي اعتبره الكثيرون المسيح. ويتجلى هذا الحرج في رواية متى لمعمودية يسوع (متى ٣: ١٤ وما يليه).
يمكن رؤية دليل على استمرار اتباع المعمدان في العصور اللاحقة في سفر أعمال الرسل. كانت هناك مجموعة صغيرة من تلاميذه في أفسس (أعمال الرسل ١٩: ١-٧)، وكان أبلوس الإسكندري أيضًا من تلاميذه (أعمال الرسل ١٨: ٢٥). خارج العهد الجديد، تؤكد اعترافات كليمنتين (القرن الثالث، ولكنها تستند إلى كتابات أقدم) أن طوائف مختلفة نشأت لإحباط الكنيسة الناشئة. وشملت هذه الطوائف تلاميذ المعمدان، الذين ادعوا، استنادًا إلى متى ١١: ١١، أنه المسيح. غالبًا ما يُفهم هذا على أنه كانت هناك طائفة معمدانية ادعت هذا في القرن الثاني؛ ولكن هذا ليس ما قيل بالضبط، وقد يكون هذا الافتراض خاطئًا تمامًا. لكن إمكانية استمرار الجماعات المعمدانية في سوريا مدعومة بالتقاليد المندائية، على الرغم من أن النظام لا يحدده بالرجل من السماء، بحيث لا يزال لديه دور ثانوي.31 هناك أيضًا أدلة آبائية على أن بعض الغنوصيين يتتبعون أصولهم إلى سمعان ماجوس ودوسيثيوس ، اللذين كانا من أتباع المعمدان في السامرة (لا تعرف النصوص المندائية شيئًا عن هذا). ومن هذه الأدلة المتفرقة، بنى رايتزنشتاين وآخرون نظرية مفادها أن هناك حركة معمدانية كبيرة ومهمة، والتي كان من الممكن أن تشكل تهديدًا خطيرًا للمسيحية في سوريا. وقد تبنى بولتمان هذه النظرية لأسباب واضحة، لكنها غير آمنة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها دليلاً لفهم إشارات يوحنا إلى المعمدان.32
من الأرجح أن يوحنا يقارنه بيسوع لنفس السبب الذي دفع الأناجيل الإزائية إلى مقارنته به، وهو أنه كان معروفًا أن يسوع كان ينتمي إليه بطريقة ما، وأن هذا كان سببًا لإحراج الاعتذاريات المسيحية لليهود، الذين اعتبروها ضد الادعاءات المسيحية. من هذا المنظور، لا يقدم الإنجيل الرابع سوى دليل على اللقاء اليهودي المسيحي. وتصبح الحاجة إلى افتراض معارضة الجماعات المعمدانية النشطة غير ضرورية.
4. جدل ضد الدوسيتية
إن قضية الجدل ضد الدوسيتية أقوى بكثير، وقد قدمها هوسكينز بشكل مقنع. إن الدوسيتية، التي غالبًا ما تسمى أول بدعة مسيحية، هي اتجاه أكثر من كونها موقفًا عقائديًا مُصاغًا. يظهر وصف بعض المسيحيين بأنهم دوسيتيون ( dokētai ) لأول مرة في رسالة سيرابيون.33 وهو يُقدم تحذيرًا ضد كتاب معين يؤكد أن المخلص ظهر فقط ( dokein ) بجسد بشري مخلوق وظهر فقط ليموت على الصليب. يرتبط هذا باستخدام dokein في إغناطيوس ( Tral.x )، الذي كان مهتمًا جدًا بهذه القضية. تنشأ البدعة من ثنائية الفكر الهلنستي، الذي يرى أن النظام المخلوق ينتمي إلى جانب الشر والفناء، مقابل العالم الإلهي للخير والخلود. إذا كان يسوع هو مخلص البشر (هكذا تسير الحجة)، فيجب أن ينتمي إلى العالم الإلهي، وبالتالي لا يمكن أن يكون له وجود بشري حقًا. إن هذه العقيدة هي افتراض معظم الأنظمة الغنوصية، ولكنها قد تكون عرضة للظهور حيثما سادت الأفكار الهلنستية.
كان من المحتم أن يؤدي توسع الكنيسة بين الأمم إلى صعوبات في هذه المرحلة. كانت كلمة “جسد” ( sarx ) كلمة سيئة بين من يحملون هذه الأفكار. كان بإمكانهم الموافقة مع بولس على أن “الله قد فعل ما عجز عنه الناموس، إذ أضعفه الجسد…” (رومية 8: 3 أ). كان من الصعب قبول كيفية فعله. “إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد” (رومية 8: 3 ب). لكن “الشبه” غامض ؛ بولس أكثر تحديدًا في كولوسي 1: 22: “لقد صالحكم الآن في جسده البشري بموته”. تتضح المشاكل أكثر عندما نصل إلى الرسائل الرعوية. لا يكتفي الكاتب بالتأكيد على أنه “ظهر في الجسد” (1 تيموثاوس 3: 16)، بل يشير أيضًا إلى العواقب العملية لهذه البدعة: “كل ما خلقه الله صالح، ولا يُرفض شيء إذا أُخذ مع الشكر” (4: 4). وعندما نصل إلى رسائل يوحنا، نجد أن الموضوع مُلحّ: “كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع فليس من الله. هذا هو روح ضد المسيح” (1 يوحنا 4: 2 وما يليه؛ قارن 1: 1-3؛ 2: 22؛ 2 يوحنا 7). تخيّل إذن مدى فعالية ذروة مقدمة الإنجيل: “والكلمة صار جسدًا” (1: 14).
الفكرة هي أن الخلاص، بمفهومه الثنائي، يُفقد النظام العالمي الحالي أهميته. أولًا، يُفضي إلى الزهد، إذ لا يُبالي الإنسان الروحي بحركات الجسد (راجع تيموثاوس الأولى ٤: ٤، المذكورة آنفًا). ثم، تحت ضغط الجسد نفسه، يُفضي إلى انحلال أخلاقي مُطلق، إذ يشعر المُستنير بأنه مُتحرر من قيود الجسد، الذي يُمكنه حينئذٍ أن يفعل ما يشاء دون أن يلمس ذاته الحقيقية، آمنًا في الحياة العليا. إن الأساس التوحيدي والأخلاقي القوي للمسيحية، المُستمد من اليهودية، لا يسمح بمثل هذه المفاهيم المُنحرفة. الخلاص هو الانتقال من عصر إلى آخر، وقد تحقق بالفعل بتمجيد المسيح. إنه في جوهره رؤية خطية، تتطلب لغة علم الآخرة، ولا تُقارب خلود الميتافيزيقا اليونانية إلا بقدر ما يُركز على التوقع الحالي للعصر القادم (راجع ص 22 وما يليه أعلاه). المتطلبات الأساسية للمشاركة في العصر الجديد هي التوبة والإيمان (راجع مرقس 1: 15). وبالتالي فإن الفئات الأخلاقية مهمة للغاية. تبدو فكرة “الجسد” في الفكر اليهودي والمسيحي غامضة في بعض الأحيان. إنها محايدة أخلاقياً بشكل صحيح، ولكن عندما تمثل النظام المخلوق في تباين مع الله، فإنها تميل إلى التأكيد على ضعف مجرد الخلق (راجع إشعياء 31: 3؛ متى 16: 17؛ رومية 8: 3 أ، المذكورة أعلاه). هذا التباين هو المقصود في يوحنا 3: 6، حيث يتم وضع الجسد ضد الروح (انظر الملاحظات في نفس المكان، وراجع 1 ق 15: 50). ولكن الانتقال من عصر إلى آخر قد تم في شخص المسيح. لقد تم ذلك على مستوى هذا العالم. إنه في الأساس إنجاز أخلاقي. وبالتالي من الضروري أن نؤمن بأنه تم ذلك في الجسد، على مستوى البشرية حيث ينتمي الإنسان.
إن رسالة يوحنا الأولى قاطعة في هذا الموضوع لدرجة أنه من المتوقع فورًا أن يُعنى الإنجيل به تحديدًا. ينكر كيسمان ذلك، مُستندًا إلى أن كريستولوجيا يوحنا تُظهر في الواقع ميلًا إلى الدوسيتية (راجع ص 21 أعلاه). صحيح أن المقاطع الرئيسية لا تنتمي إلى الطبعة الأولى من الإنجيل (1: 14؛ 6: 51ب-8 – ولكن قارن 6: 63، التي ربما تُشير إلى الاتجاه المعاكس؛ 19: 35). لكن وجهة نظر كيسمان لا تُصبح معقولة إلا عندما يقتصر الاهتمام على الأفكار المميزة، ويُتجاهل ما يشترك فيه يوحنا مع بقية العهد الجديد؛ وقد جادلنا سابقًا بأن وحدة الإنجيل الكلية أعظم من أن تسمح بأي نظرية تتطلب تقسيم الكتاب إلى خيوط مختلفة تُجسد آراءً متضاربة. لا يشير يوحنا فقط إلى يسوع باعتباره المسيح وابن الإنسان الرؤيوي، بل يحتفظ أيضًا بالمبدأ المسيحي المركزي القائل بأنه، على عكس المتوقع، مات ميتة مجرم. لا يوجد أي تلميح إلى أن يسوع بدا وكأنه مات فقط؛ إن حقيقة أن الغنوصيين، الذين يعتنقون آراء دوسيتية، كانوا أول من قيم الإنجيل الرابع تُظهر فقط أنه من الممكن تفسيره بهذه الطريقة، بالنظر إلى افتراضاتهم – مواقفهم، ولا تثبت أن يوحنا كان سيوافقهم الرأي. إذا كان، كما يبدو مرجحًا، أن رسالة يوحنا الأولى هي للمؤلف نفسه، وكتبت في وقت لاحق للإنجيل، فيمكننا أن نستنتج أن مناهضة الدوسيتية، التي بدأت تظهر في الطبعة الثانية من الإنجيل، أصبحت في النهاية انشغالًا أكثر جدية للمؤلف. ربما كان هذا بسبب سوء تفسير وسوء فهم الإنجيل نفسه.
١٠. القيمة الدائمة للإنجيل الرابع
إن الإنجيل الرابع عملٌ بارعٌ ومؤثرٌ للغاية كتفسيرٍ للمسيح، لدرجة أنه يصعب تصديق أن أصوله غامضةٌ إلى هذا الحد، وأنه شق طريقه إلى حياة الكنيسة ببطءٍ شديد. ولكن هذا حدث في مرحلةٍ حرجة. فقد كانت سيطرة الذاكرة الحية ليسوع في طريقها إلى الزوال، ولفت التوسع في العالم الوثني انتباهَ رجالٍ ذوي عقولٍ قوية، كانت عقولهم متأثرةً بالثقافة الهلنستية؛ ويشهد صعود الغنوصية على المشاكل التي شغلت عقول هؤلاء الرجال. وفوق كل شيء، كانت مشكلة التوفيق بين الإيمان المسيحي وافتراضاتهم الكونية هي التي تطلبت حلاً بإلحاحٍ شديد، ومثلت أخطر المخاطر. لأن الاتجاه كان، كما كان دائمًا، أن يكون الحل انعكاسًا لروح العصر، أي نظرة العصر. وكان من السهل جدًا فقدان جوهر الإنجيل في هذه العملية؛ والدوسيتية مثالٌ على ذلك. إن الصراع الفكري الذي شهدته القرون الخمسة الأولى هو سجل للصراع بين وجهات النظر المتعارضة، وللتوصل إلى حل متفق عليه ومقبول.
كُتب الإنجيل الرابع في الوقت الذي بدأت فيه هذه القضايا تلوح في الأفق. وقد استولى عليه الغنوصيون لما بدا أنه يدعم آرائهم. ثم بدأ يشق طريقه في الأوساط الأرثوذكسية. ولا يخفى على أحد أن “اكتشافه” كان له تأثير عميق على بقاء المسيحية الأرثوذكسية. فقد تميّز بميزة فريدة تتمثل في مراعاة بعض المسائل التي كانت تستغيث بالحلول، وفي الوقت نفسه، ترسيخه الراسخ في الحقائق التاريخية للتقاليد البدائية. 34 ويؤكد أوريجانوس هذه النقطة عندما يشكو من أن الكثيرين يُولون “كل اهتمامهم للمسيح باعتباره الكلمة، متجاهلين تقريبًا الألقاب الأخرى العديدة المنسوبة إليه” ( i: 21Comm. in Joh). وبالطبع، كان هذا العنصر، قبل كل شيء، هو الذي أتاح سبيلًا للتوفيق بين الإيمان المسيحي وعلم الكونيات في ذلك العصر.
النقطة التي تهم بشكل رئيسي الفترة الآبائية، والتي تفسر التركيز على المقدمة، كانت تفسير المسيح من حيث عقيدة التجسد. وهذا في الواقع مسألة ذات قيمة دائمة، ولكن قد ينبهر القراء المعاصرون بنفس القدر بميزة فريدة أخرى من سمات يوحنا – مفهوم مجد الله المتجلى في آلام المسيح. ويظهر هذا في المعنى المزدوج لعبارة “رفع ابن الإنسان” (3: 14؛ 8: 28؛ 12: 34)، والتي تشير إلى كل من الصليب وتمجيد يسوع. ثم هناك الإعلان الدرامي بأن “الآن” هو الوقت الذي “يُمجَّد فيه ابن الإنسان” عندما تصل لحظة الآلام (12: 23؛ 13: 31). هذا التأكيد، إلى جانب التجسد، يعطي قطبين أساسيين في عقيدة يوحنا المسيحية. والصورة الناتجة، على كل عيوبها، تعطي فكرة مقنعة للغاية عن العلاقة الأخلاقية بين يسوع والآب. “الآب يحب الابن، ويُريه كل ما هو صانع… لا أستطيع أن أفعل شيئًا من تلقاء نفسي… لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني” (5: 20، 30). التجسد هو فعل “الإرسال”. الآلام هي الاختبار النهائي للطاعة البنوية (12: 27 وما يليه). تتجلى لمحات العلاقة بين الآب والابن في جميع أنحاء الإنجيل، وتبلغ ذروتها في 10: 30: “أنا والآب واحد”. ودون النظر في الدلالات الميتافيزيقية المحتملة لهذه الآية، يمكننا بالتأكيد أن نرى هنا وحدة الإرادة، وشركة كاملة بين الآب في السماء والابن على الأرض.
إن مفهوم يوحنا للعلاقة بين الآب والابن متجذر في التقليد السابق، ولكن من الواضح أنه مدين بشيء لتجربته الخاصة. كانت لديه القدرة على الدخول بشكل خيالي في معنى التقليد؛ كانت روحانيته الخاصة من النوع الذي يمكنه من تصور علاقة يسوع بالآب بهذه الطريقة. علاوة على ذلك، فهو يبذل قصارى جهده لإظهار أن نفس التجربة متاحة للتلاميذ – أي للقارئ – أيضًا. وعلى عكس الغنوصيين، لا يقدم يوحنا أي إشارة إلى أنها تنطبق فقط على النخبة المتميزة. جميع الناس مدعوون للمشاركة من خلال المسيح في شركته مع الآب (14: 20؛ 17: 20 وما يليه). سيتعين عليهم تحمل دورهم في الصليب (15: 18-27)، ولكن فيه سيجدون السلام (14: 27). إن نقل هذه التجربة هو أحد أهداف يوحنا المركزية.
اليوم، مع تقدّم العلم الذي يُضعف النظرة العالمية لعصر العهد الجديد دون إعادة تفسير جذرية، من المرجح أن تكتسب التجربة المُجسّدة في الإنجيل الرابع أهمية خاصة. وقد كان بولتمان رائدًا في هذا المجال، إذ ترجم الإنجيل من علم الكونيات الأسطوري إلى الاهتمام الحديث بمعنى الوجود. قد لا نتفق مع تحليله لمصدر الإنجيل، ولكن لا يُمكن لأحد أن يُجادل في جدية هدفه. فالإنجيل الرابع يُمكّننا بالفعل من رؤية يسوع تأكيدًا على معنى الوجود من منظور الشخصية البشرية؛ كما يُعطي لاهوت الكلمة المتجسد مكانة مرموقة لمركزية الأخلاق في عالم آلي؛ وتؤكد حياة يسوع وموته وقيامته معنى الوجود في مواجهة حقائق الحياة والموت القاسية في الكون كما نعرفه. يتخذ هذا التأكيد شكل استجابة شخصية وأخلاقية للكلمة، التي هي نطق الوجود المخلوق. الكلمة التي تُسمع من خلال التأمل في يسوع هي الكلمة التي يجب أن تُطاع بحركة محبة من الإرادة والعقل والقلب. وليس من قبيل الصدفة أن تكون كلمتا “السمع” و”الطاعة” كلمة واحدة في العبرية ( شاما؛ راجع ٥: ٢٥). فالسمع الحقيقي لا ينفصل عن الاستجابة المطيعة؛ وموقف يسوع الأبوي، كابن للآب، هو الأسلوب الأمثل للاستجابة لمعنى الوجود.
إذا كان الإنجيل الرابع قابلاً لإعادة التفسير من منظور وجودي، فهذا يعني أن التجربة التي يتضمنها ليست بالضرورة مرتبطة بإطار عقائدي جامد، بل يمكن أن تكون ملكًا مشتركًا لجميع الباحثين عن الحقيقة. لكن من الضروري فهمه أولًا في إطاره المرجعي الخاص. سيكون من السهل جدًا تكرار خطأ الغنوصيين الأوائل، وفرضه في خدمة نظام فكري غريب عن روحه. فقط عندما يتم إتقان رسالته الأساسية، يمكنه أن يساهم في حل مشاكل المستقبل. يقول يوحنا في المقدمة: “لم يرَ أحد الله قط”. بالنسبة لنا اليوم، يمثل هذا أكثر من مجرد موقف عقائدي حاخامي. إنه يمثل عدم يقين الحياة والمستقبل، الذي يخيم على البشر وقد يؤدي بهم إلى اليأس. لكن لدى يوحنا تأكيد يؤكده في الوقت نفسه: “الابن الوحيد، الذي هو في حضن الآب، هو الذي عرّفه”. وفي الفصول التالية يستخلص من القارئ استجابة الإيمان، التي تقود إلى بُعد جديد من الأمل عندما يكتشف معنى الحياة في المسيح.
حواشي المقدمة
1 راجع مولي، ولادة العهد الجديد، الفصل 5.
2 مختصر من كتاب دود، الوعظ الرسولي، ص 28.
3 قارن بين المصدر الإزائي Q وإنجيل توما الغنوصي، اللذين هما مجموعات غير واضحة المعالم بدون إطار سردي.
4 كليمنت الإسكندري، نقلاً عن يوسابيوس،.7 HE VI.xiv.
5 للحصول على عرض جديد وجذاب للرأي التقليدي، انظر إدواردز، إنجيل القديس يوحنا.
6 انظر قائمة الاعتراضات التي جمعها باركر في JBL LXXXI.
7 نقلاً عن إبيفانيوس، بان هاير، المجلد الثالث.
8 اقترح شناكينبورج أن الشخص الأول “أنا” كان في الأصل يمثل التقليد، والذي تم تغييره إلى الشخص الثالث (‘التلميذ الذي أحبه يسوع’) من قبل مدرسة يوحنا المسؤولة عن تجميع الإنجيل.
9 انظر مقالته في الطبعة الحادية عشرة من الموسوعة البريطانية.
10- تمت معالجة موضوعات العهد القديم في إنجيل يوحنا بالتفصيل بواسطة براون، جان لو ثيولوجي الثاني (1964).
- 11. بوكر، “أصل وهدف إنجيل القديس يوحنا”.
12 دود، التفسير، ص 68. ويمكن لفيلو أن يشير إلى الكلمة مجازيًا باعتباره ذرية الله أو ابن الله (ص 71).
13 دود، التفسير، ص 117.
14 راجع كولبي، “ماندير”.
15 انظر أيضًا Excursus vi. “الأسطورة الغنوصية للمخلص وعقيدة يوحنا المسيح”، في Schnackenburg ، ص 543-557.
16 انظر مقال دود، “إنجيل جديد”، في مجموعته لدراسات العهد الجديد، ص 12-52.
17 نقلاً عن يوسابيوس، HE ш.xxxix . 16.
18 راجع S. Brown، CBQ xxvi.
19 بيرني، أصل آرامي.
20 كولويل، اليونانية من الإنجيل الرابع.
21 بونسيرفن ، في HTR xx.
22 النهج الأسود الآرامي.
23 بالنسبة للميزات اللغوية الأخرى، انظر باريت، ص 7-11، وشفيزر، إيجو إيمي ، ص 87-99.
24 للحصول على نقد متعاطف لنظرية بولتمان، انظر د. مودي سميث، “مصادر إنجيل يوحنا: تقييم للحالة الحالية للمشكلة”، NTS x (1963-4)، ص 336-351.
25 راجع لايتفوت، التاريخ والتفسير، ص 110.
26 انظر إليس، إنجيل لوقا، ص 55-58، للمناقشة الحالية حول هذه المسألة.
27 تم جمعها بشكل ملائم في العمل الشعبي لهانتر، وفقًا ليوحنا، الفصلين 8 و9.
28 ماكجريجور ومورتون، بنية الإنجيل الرابع.
29 في هذا الفصل، يرى العديد من الباحثين أن الفقرات 6.51ب-8 إضافة لاحقة. وقد أشار براون إلى أن بعض مواد الخطابات كانت موجودة بصيغ مكررة، وقد استخدمها المحرر النهائي. ولذلك، اعتبر الفقرات 6.35-50 و51-8 نسختين مكررتين، على الرغم من الاختلافات الكبيرة بينهما.
30 راجع كتابي “الاعتذاريات في العهد الجديد”، الفصل 3.
31 راجع كولبي ، المادة المذكورة.
32 راجع روبنسون، تي إن تي، ص 49، ملاحظة 49.
33 أسقف أنطاكية، 199-211 م . الرسالة محفوظة في يوسابيوس، HE VI.xii .
34 تمت مناقشة هذه القضايا في Braun, ш (1968).