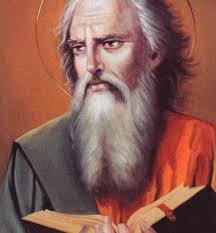منهجية النقد النصي:
وتعني الطريقة التي يرجح عن طريقها علماء النقد النصي بين القراءات المختلفة التي تقدمها تقاليد المخطوطات لنفس وحدة الاختلاف النصي من العهد الجديد. وقد وضعوا معايير للترجيح. وهناك معيار واحد فوق كل المعايير الأخرى يدير اختيار الباحث في دراسة أي وحدة من الاختلاف النصي: من المرجح أن يكون “الاختلاف” الذي يفسر مصدر الأخرين (أي سبب ظهورهم) هو الأصلي غالبا. و من أجل “أفضل تفسير لأصل الآخرين” ، هناك عاملان يجب على العلماء اعتبارهما: الأدلة الخارجية (القيمة التاريخية للمخطوطات نفسها) والأدلة الداخلية (التي لها علاقة بالمؤلفين أو الكتبة أو الأسلوب).
الأدلة الخارجية
أول شيء يجب على المرء فعله عند أي حالة اختلاف نصي هو وزن دلالة المخطوطات الداعمة لكل اختلاف. وبالتالي، يسأل المرء عادة الأسئلة التالية: كم عمر الشواهد الذين يدعمون كل اختلاف أو كم عمر نصهم؟ ما مدى الجودة العامة للمخطوطات؟ ما مدى اتساع التوزيع الجغرافي للشواهد؟ هذا السؤال الأخير مهم بشكل خاص، لأن التوزيع الجغرافي المبكر والواسع النطاق لقراءة ما يشير الى الأصل الأول قبل أن تنتشر الوثيقة المعنية على نطاق واسع في جميع أرجاء الكنيسة المبكرة. وعلى الرغم من ذلك، ومع بعض الاستثناءات، اتفق العلماء على أن معرفة العمر أو التوزيع الجغرافي للشهود الأوائل لا يضمن بأي حال العثور على النص الأصلي.
الأدلة الداخلية
الأدلة الداخلية هي نوعين: الاحتمالية النسخية (Transcriptional probability) أي ما هو نوع الخطأ أو التغيير الذي ربما يكون قد قام به الناسخ) والاحتمالية الجوهرية (Intrinsic probability) (ما الذي من المرجح أن يكون المؤلف قد كتب).
- 1. الاحتمالية النسخية Transcriptional probability:
لها علاقة بالأخطاء النسخية وتستند إلى معايير معينة مستقاة من الناحية الاستقرائية. على سبيل المثال، عادة ما يكون صحيحًا أن القراءة الأكثر صعوبة ربما تكون هي القراءة الأصلية، لأن النساخ كانوا يميلون لجعل النص أسهل في القراءة. ومرة أخرى، القراءة الأقصر تكون عادة هي القراءة الأصلية، لأن النساخ كانوا يميلون إلى الإضافة إلى النص لتوضيحه. ومع ذلك، يجب استخدام هذا المعيار بحذر شديد لأن النساخ أحيانًا قاموا بالحذف من النص إما لجعله أكثر سلاسة أو لإزالة ما قد يكون مرفوضًا. أخيرًا، الاختلاف النصي الذي يكون مغايرا عن المادة المقتبسة أو الإزائية يكون تقريبا دائمًا أصليًا، حيث كان ميل النساخ هو التوفيق والمجانسة بين الفقرات القريبة من بعضها البعض.
- 2. الاحتمالية الجوهرية Intrinsic probability:
هي العنصر الأكثر ذاتية في منهجية النقد النصي. ويتعلق هذا الأمر بأسلوب ومفردات المؤلف، وأفكاره كما هي معروفة في مكان آخر من كتاباته، وكذلك الاحتمالات القائمة على السياق الحالي.
ليست كل المعايير المذكورة أعلاه قابلة للتطبيق بالتساوي في كل حالة؛ في الواقع، في بعض الحالات يعارضون بعضهم البعض. على سبيل المثال، قد تكون القراءة الأطول هي الأكثر صعوبة، أو القراءة الأكثر توافقًا مع أسلوب المؤلف قد تكون توافقية مع هذا النمط النصي. وفي مثل هذا المأزق، عادة ما يُجبر الناقد النصي على العودة إلى الأدلة الخارجية كحكم نهائي.
تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لمعظم العلماء، يتم حل أكثر من تسعين في المئة من جميع الاختلافات في نص العهد الجديد، بسبب أنه في معظم الحالات يكون الاختلاف الذي يفسر أصل ظهور الآخرين بشكل أفضل يكون مدعوما من قبل أقدم وأفضل الشهود. “إيب وفيي ص 14-15”
الاختلاف حول المنهجية (النظرية النصية)
- الطريقة الوثائقية-التاريخية: تحاول الطريقة الأولى إعادة بناء تاريخ نص العهد الجديد من خلال تتبع خطوط الإنتقال مرة أخرى من خلال المخطوطات الموجودة لدينا إلى المراحل الأبكر ثم اختيار القراءة التي تمثل أقدم مستوى ممكن للتقليد النصي والتي تكون أقرب للنص الأصلي عن غيرها. وقد كانت طريقة هورت للأنساب في المخطوطات، هي الأقرب لذلك والتي تبنى فيها قراءة الشهود المصريين عموما، إلا إذا أثبتت الأدلة الداخلية أنها معدلة ثانويا، لكن البعض رفض ذلك ولم يعتبر النص المصري “محايدا” كما هو رأي ويستكوت وهورت. “إيب وفيي ص 32”
- على الجانب الآخر، هناك طريقة “انتقائية صارمة” يمارسها كيلباتريك وتلميذه إيليوت، فإنهم يدعون إلى عدم إعطاء أي وزن لوضع القيمة التاريخية لدليل المخطوطات على الإطلاق فهم ليسو مهتمين بعمر أو مكانة أو شعبية المخطوطات الداعمة للقراءات التي ستعتمد كقراءة أصلية “، ولكن اتخاذ كل خيار على أساس المبادئ الداخلية فحسب مثل تناسب سياق الفقرة أو أسلوب المؤلف ومفرداته أو لاهوت المؤلف، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل العادات النسخية، بما في ذلك ميلهم إلى انسجام النص ليتوافق مع أسلوب اليونانية العامية المختلطة الكوين أو الأتيكية اليونانية. وتكمن الصعوبة في هذه الطريقة في أن النتائج تعتمد على تفضيلات العالم أو الباحث بين المعايير الداخلية ذاتها، والتي في حالة كيلباتريك وإيليوت يبدو أن تفضيلهما يكون للاختلاف النصي المتفق مع أسلوب الكاتب (من الاحتمالية الجوهرية) أكثر منه مراعاة مسائل الاحتمالية النسخية. “إيب وفيي ص 34”
- الانتقائية المسببة: وهي وسطية بين الطريقتين السابقتين، وفيها سنختار قراءة في أي حالة معيّنة بحيث تكون مندرجة في واحدة من المجموعات الأبكر والتي في نفس الوقت الأكثر تناسبا مع الإعتبارات الداخلية ذات الصلة. لذلك، تستخدم هذه الطريقة المعايير الخارجية والداخلية وتسمى “انتقائية مسببة” أو “انتقائية معتدلة” أو “انتقائية حقيقية”، أو ببساطة الطريقة “الانتقائية”، لأنها تستخدم أفضل الطرق المتاحة من جميع أنحاء الطيف المنهجي. وفي هذه الطريقة، من المعترف به أنه لا يوجد معيار واحد أو مجموعة ثابتة من المعايير ستحل جميع حالات الإختلاف النصي، وبالتالي فهي تحاول أن تطبق بالتساوي -وبدون حكم مسبق -أي أو جميع المعايير -الخارجية والداخلية – المناسبة لكل حالة بعينها، ويكون التوصل إلى إجابة على أساس الاحتمالات النسبية بين تلك المعايير الممكن استعمالها. ويعني هذا بشكل أساسي أن النص “الأصلي” للعهد الجديد يجب أن يتم اختياره “اختلافا نصيا بعد الآخر”، وذلك باستخدام جميع مبادئ الحكم النقدي دون اعتبار مخطوطة واحدة أو نوع نصي واحد باعتباره أنه يحفظ النص “الأصلي” ضرورة. “إيب وفيي ص 35”
- وهناك نوع من الانتقائية مع ميل لنوع معين من النصوص، فعندما تكون جميع المعايير الأخرى متساوية، تميل إلى اتباع هورت وتتبني قراءات الشهود المصريين (السكندرية). يمكن ملاحظة ذلك بدرجة أكبر في إصدار (جمعيات الكتاب المقدس المتحدة) UBS. أو إلى حد ما يتم إعطاء الشهود الغربيين الأوائل اهتمام أكثر بقليل من النصوص المصرية، كما في النصوص اليونانية التي وراء النسخة القياسية المنقحة (RSV) والنسخة الإنجليزية الجديدة (NEB)،
- وهناك نوع من الطريقة الانتقائية مع التحيز لنوع نصي معين ” الانتقائية الغربية “ التي يتم التركيز فيها بشكل كبير وأساسي على تفضيل القراءات الأقصر كما هي موجودة في العديد من الشهود الغربيين، وخاصة الترجمات القديمة والاقتباسات من بعض الآباء. وهي دعا بويزمارد إليه. وتم استخدامه في ترجمة مولات لانجيل يوحنا في نسخة إنجيل القدس (Jerusalem Bible) لكن يبدو أن العيب في هذه الطريقة تكمن في تفضيل الترجمات واقتباسات الآباء على التقليد اليوناني بأكمله، خاصة وأن العديد من القراءات الأقصر قد تظهرعلى أنها إعادة صياغة نصية أو اقتباسات غير موثوقة يبدو أنها من الذاكرة.
وكما سبق أن قيل، قد نعترف أن جميع مبادئ النقد النصي لا تكون قابلة للتطبيق على كل اختلاف نصي، إلا أن النقاد المعاصرين يتفقون عمومًا على أن أسئلة الأدلة الداخلية عادةً يجب أن تُطرح أولاً وأن وزن دليل المخطوطات يجب أن يطبق ثانيا. ومع ذلك، يبدو واضحا أنه طبقا للأدلة الداخلية، تميل بعض المخطوطات إلى دعم النص “الأصلي” في كثير من الأحيان أكثر من غيرها وتلك المخطوطات هي المصرية المبكرة (كما عند ويستكوت وهورت)، لذلك عندما لا تستطيع الأدلة الداخلية التحديد، يكون الطريق الأكثر أمانًا هو الذهاب إلى المخطوطات “الأفضل” أي على أساس الأدلة الخارجية.
وتعتبر الطريقة “الانتقائية المسببة” هي الاختيار الأنسب في الوقت الحالي لكن كما قال كينيث كلارك عن تلك الطريقة في عام 1956: “إنه الإجراء الوحيد المتاح لنا في هذه المرحلة، لكن من المهم للغاية إدراك أنها طريقة ثانوية ومؤقتة. إنها ليست طريقة جديدة ولا دائمة. ولا يمكن للطريقة الانتقائية في حد ذاتها إنشاء نص ليحل محل ويستكوت-هورت وسلالته. إنها مناسبة فقط للاستكشاف والتجريب …. تنتمي الطريقة الانتقائية بطبيعتها إلى عصر مثل عصرنا الذي نعرف فيه فقط أن النظرية التقليدية للنص خاطئة ولكن لا يمكننا حتى الآن أن نرى بوضوح كيف يكون تصحيح الخطأ”. وهذا يعني أننا لو وضعنا التاريخ المبكر الكامل للنص، على النحو المنصوص عليه في الطريقة الوثائقية التاريخية فسيكون هو المنهج الأمثل. “إيب وفيي ص 36”
قوانين النقد النصي أو معايير الترجيح بين النصوص
قوانين جريسباخ Griesbach (1806):
وهي خليط من تطبيق المعايير الخارجية والداخلية.
الأول: “القراءة الأقصر … أفضل من القراءة المطولة” وذلك فقط عندما تكون القراءة المعنية تحظى ببعض الدعم من “الشهود القدامى والثقال” وتكون أصالة القراءة الأقصر تكون أكثر يقينًا
(أ) إذا كانت أيضًا أكثر قسوة وأكثر غموضًا وغرابة ومقتضبة وكئيبة وغير نحوية
(ب) إذا تم التعبير عن الأمر نفسه بطريقة مختلفة في مختلف المخطوطات،
(ج) إذا كان ترتيب الكلمات غير ثابت وغير مستقر،
(د) إذا كانت القراءة تقع في أول مقدمة (أو درس الكنيسة) أو
(هـ) إذا كانت القراءة الأكثر طولا تُظهر دليلًا على وجود توضيح أو تفسير، أو كانت متفقة مع كلمات في مقاطع إزائية، أو يبدو أنها مأخوذة من كتيب طقوسات كنسية،
لكن القراءة الأقصر لا تكون هي الأفضل (إلا بدعم شهود بارزين) إذا كانت:
(أ) أقل ملاءمة لشخصية المؤلف أو أسلوبه أو هدفه،
(ب) لا معنى لها على الإطلاق، أو
(ج) ربما تمثل اقتحام من عبارة إزائية أو من كتيب طقوسات كنسية.
الثاني: “القراءة الأكثر صعوبة والأكثر غموضا هي الأفضل عن تلك التي كل شيء فيها واضح جدا ومنقى من الصعوبات بحيث يكون كل ناسخ قادرا بسهولة على فهمها. “
الثالث: ” القراءة الأقسى (أو الأكثر صرامة) هي المفضلة لتلك التي تتدفق بكل لطف وسلاسة. تشير كلمة “الأقسى” إلى قراءات مقتضبة، أو كئيبة، أو غير نحوية، أو على عكس الاستخدام اليوناني العادي، أو كريهة إلى الأذنين (لأقصى حد).
الرابع: “القراءة الأكثر غرابة هي المفضلة عن تلك التي لا تشكل شيئًا غير عادي. والوصف “غير عادية” يعني الكلمات النادرة والكلمات التي معانيها نادراً ما تستخدم، والعبارات والإنشاءات غير الشائعة.
الخامس: “التعبيرات الأقل تشددًا (بلاغيًا)، شريطة ألا يتطلب سياق وهدف المؤلف التأكيد، تكون أقرب إلى النص الأصلي من القراءات التي تمتلك، أو يبدو أنها تمتلك، قوة بلاغية أكبر، لأنه بالنسبة للنساخ اللامعين، كمثل المعلقين، يحبون ويبحثون عن النبرات (البلاغية). “
السادس: ” القراءة، مقارنة مع الآخرين، التي تنتج معنى مناسب لدعم التقوى (وخاصة التقوى الرهبانية) هي موضع شك “.
السابع:” القراءة الأفضل من الآخرين هي القراءة التي تحمل (للوهلة الأولى) ما يبدو أنه معنى خاطئ، ولكن هذا المعنى، بناءً على فحص دقيق، وجد أنه صحيح. “
الثامن: ” من بين العديد من القراءات في مكان واحد، تعتبر تلك القراءة مشبوهة بحق إذا كانت تتناسب بوضوح مع الآراء الأرثوذكسية أكثر من القراءات الأخرى، “لأنه كان من المستحيل على ناسخ كان راهبًا مكرسًا للكنيسة أن يتجاهل أي قراءة ظهرت بقوة لتأكيد أي عقيدة كاثوليكية أو تدمير بدعة.
التاسع: هذه الشرائع تعامل السجع والظواهر ذات الصلة، والقراءات الناشئة عن هذا “التماثل” اللغوي تكون “بلا قيمة” و “ترفض بحق”.
العاشر: “تفضل القراءة، من بين الكثيرين في نفس المكان، التي تكمن في منتصف الطريق بين الآخرين، أي القراءة، كما كانت، تجمع الخيوط بطريقة بحيث، إذا تم قبول هذه القراءة باعتبارها أصلية، يصبح من الواضح كيف) أو بعبارة أوضح، من أي أصل للخطأ (نشأت جميع القراءات الأخرى منها. “
الحادي عشر: ” ترفض القراءات التي يشتم منها رائحة توضيح أو تفسير
الثاني عشر: ” تستبعد القراءات التي أدخلت في النص من تعليقات القدماء أو مدارس الآباء”.
الثالث عشر: ” نحن نرفض القراءات التي تظهر أصلاً في كتيبات الطقوسيات الكنسية. “
الرابع عشر: وأخيرا، “لا تقر قراءات أدخلت من الترجمات اللاتينية في الكتب اليونانية “إيب وفيي ص 151-152”
مبادئ لاخمان Lachmann (1842)
وضع لاخمان مبادئه الخاصة بالنقد النصي بطريقة أكثر انتظامًا وكانت كلها معايير خارجية، حيث كان هدفه هو إعادة بناء النص المنقول من القرن الرابع، ولهذا الغرض بدت المعايير الخارجية كافية. على النحو التالي:
- ليس هناك ما هو أفضل من ذلك الذي توافق عليه جميع الوثائق.
- إذا كانت بعض الوثائق صامتة أو معيبة، وزن الأدلة يقل إلى حد ما.
- عندما يكون الشهود من مناطق مختلفة، يكون اتفاقهم أكثر أهمية من كون مخطوطات جهة محلية معينة تختلف عن الباقي، إما من الإهمال أثناء النسخ أو من غرض معين.
- عندما لا يتفق شهود المناطق المختلفة واسعة الانفصال، فإن شهاداتهم يجب اعتبارها محل شك.
- عندما تكون القراءات في شكل واحد في منطقة واحدة وفي شكل آخر في منطقة أخرى، مع اتساق كبير، فهي غير مؤكدة تماما.
- أخيرًا، تعتبر القراءات ذات وثائق ضعيفة عندما لا تقدم -حتى في نفس المنطقة -شهادة موحدة. “إيب وفيي ص 154”
قوانين تشيندروف Tischendorf (1849)
- القراءات الخصوصية تماما إلى واحد أو آخر من الشهود (القدامى) تكون محل شك، وكذلك القراءات، في فئة من الوثائق، التي يبدو أنها قد نشأت من التصحيح، النقدي العلمي
- تستثنى القراءات، بغض النظر عن شهاداتهم الخارجية، تلك التي نشأت بوضوح أو بشكل محتمل من خطأ الناسخ.
- الشهود التي بها مقاطع مشابهة للعهد القديم والعهد الجديد وخاصة الأناجيل السينوبتيكية (الإزائية)، عندما تشهد على الخلافات، تكون أفضل من الشهود التي تظهر الاتفاق، لأن القدماء أولوا اهتمامًا خاصًا لأوجه الشبه.
- القراءة الأكثر احتمالا من غيرها هي تلك القراءة التي يبدو أنها قد تسببت في القراءات الأخرى أو التي لا تزال تحتوي في حد ذاتها على عناصر من القراءات الأخرى،
- يجب الاحتفاظ جديا بالقراءات التي تتفق مع اللغة اليونانية وأسلوب أفراد المؤلفين في العهد الجديد. “إيب وفيي ص 155-156”
مبادئ تريجلز Tregelles (1854)
“تشكيل نص العهد الجديد بواسطة وثائق النسخ القديمة دون السماح ‘للنص المستلم’ بأي حقوق إرشادية “وهذا النص الأساسي، الذي يتكون من معيار خارجي بالاعتماد على أقدم الوثائق، واستكمل ببيان عام حول دور المعايير الداخلية في الحسم عندما تكون الشهود القدامى في خلاف:
- تفضل القراءة التي بدت تسببت في الآخرين.
- ترفض القراءات التي تنطوي بوضوح على أخطاء من نساخ، مثل السجع
- تفضل القراءة التي تكون من النظرة الأولى غير متوافق ولكنها تؤدي لمعنى جيد بعد مزيد من التدقيق
- ترفض التوفيقات، والاقحامات من الهامش إلى النص، والتعديلات العقائدية
- تفضل القراءة التي تتناسب مع أسلوب المؤلف
- وبشكل أعم (بما أنه يشمل بعض ما سبق)، تفضل القراءة الأصعب، وتفضل القراءة الأقصر “إيب وفيي ص 156-157 “
قوانين ويستكوت وهورت Westcott-Hort (1881):
وتتميز هذه القوانين أنها:
أولا: دمجت بشكل فريد المعايير الداخلية والخارجية التي استنبطت واستخدمت على مر السنين،
وثانياً: أنها استخدمت ناتج ذلك الدمج بطريقة جديدة -مع تأثيرات بعيدة المدى على نظرية وأسلوب النقد النصي للعهد الجديد. “إيب وفيي ص 158”
- تفضل القراءات أو المخطوطات أو المجموعات الأقدم
- تتم الموافقة على القراءات أو رفضها بسبب الجودة وليس عدد الشهود الداعمين (خلافا للنص المستلم).
- إن القراءة التي تجمع بين قراءتين بسيطتين بديلتين تكون متأخرة عن القراءتين المكونتين للخليط، ولا تكون، او نادرا ما تكون، المخطوطات التي تدعم القراءة المختلطة نصوصا سابقة للخلط وذات قيمة خاصة.
- تفضل القراءة التي تؤدي أفضل معنى، وهذا هو، الذي يتوافق بشكل أفضل مع قواعد اللغة ويتوافق أكثر مع الغرض من بقية الجملة والسياق الأوسع نطاقًا.
- تفضل القراءة التي تتوافق بشكل أفضل مع الأسلوب المعتاد للمؤلف ومادة ذلك المؤلف في فقرات أخرى.
- تفضل القراءة التي تفسر بشكل أكثر ملاءمة وجود القراءات الأخرى.
- من غير المرجح أن تكون القراءة أصلية إذا جمعت بين ظهور تحسن بالمعنى مع عدم واقعيته؛ سيكون هنا لاحتمال تعديلات النساخ تفوق واضح، بينما سيكون للنص الأصلي أعلى تفوق للواقع.
- من غير المرجح أن تكون القراءة أصلية إذا أظهرت ميلًا للتخلص من الصعوبات (أي إن القراءة الأكثر صعوبة هي الأفضل).
- تفضل القراءات التي تكون في مخطوطة تحتوي عادةً على قراءات متفوقة وفقًا لما تحدده الاحتمالية الجوهرية والنسخية. ويتم زيادة اليقين إذا وجد أن هذه المخطوطة الأفضل هي المخطوطة الأقدم، وإذا كانت هذه المخطوطة تحتوي عادة على قراءات تثبت أنها سابقة على الخليط ومستقلة عن التلوث الخارجي من نصوص أخرى دنيا. وتنطبق نفس المبادئ على مجموعات المخطوطات. “إيب وفيي ص 158”
وينطوي عمل ويستكوت وهورت على:
أولاً: تقسيم المخطوطات ومجموعاتها إلى أنواع نصية مبكرة وأخرى متأخرة افتراضا بواسطة طريقة خارجية وأنسابية،
وثانيًا: تقييم الجودة أو الموثوقية النسبية لهذه المخطوطات ومجموعات المخطوطات المختلفة. والنتيجة هي حكمهم المعروف:
(1) بأن المخطوطات اللاحقة السورية (أو البيزنطية) مخطوطات مختلطة وبالتالي تكون الأبعد إزالة زمنياً ونوعياً من النص الأصلي؛
(2) أن المخطوطات مثل C وL و33 (النص السكندري) هي بشكل فردي وكمجموعة جيدة ولكنها نصوص منقحة ومصقولة، وبالتالي تتم إزالتها بعض الشيء من النص الأصلي؛
(3) أن المخطوطات مثل D وDpaul (النص الغربي) ومجموعتهما عبارة عن نصوص قديمة ولكنها فاسدة، وبالتالي تمت إزالتها من النص الأصلي من ناحية الجودة ولكن ليس من ناحية عمرها؛ و
(4) أن المخطوطات B وX هما المخطوطات “الأفضل” وأن مجموعتهما (النص المحايد) هي المجموعة “الأفضل” لأنهما قريبتان في الوقت جدا وأقرب في الجودة إلى نص العهد الجديد الأصلي.
لكن عند تطبيق هذه القوانين برزت مشكلة عدم التوازن في بعض الحالات بين المعايير الخارجية والداخلية، وذلك عندما يكون هناك تضارب في الأدلة، كما هو الحال في كثير من الأحيان، هل يتم اتخاذ القرارات الأساسية في النقد النصي (أو القدرة على اتخاذها) على أساس الاعتبارات التاريخية -التطورية والوثائقية (الخارجية) أو على أساس التقييم من العوامل السياقية، والأسلوبية، والنسخية (الداخلية)؟ وهذا ما أثار إلى حد كبير، عدم اليقين، والحيرة، والفوضى الافتراضية للنقد النصي الحديث والحالي، وتسبب في ظهور “الحركة انتقائية” بأكملها كما تمارس حاليًا في النقد النصي للعهد الجديد. “إيب وفيي ص 160”
قائمة موجزة من القوانين التي نجت من اختبار الزمن والتي تعرف بشكل عام بأنها مبادئ قابلة للتطبيق:
هناك افتراض (مع تساوي الأشياء الأخرى) للنظر في هذا الاختلاف باعتباره القراءة الأصلية الأكثر ترجيحًا حسب تلك المعايير:
- المعايير المتعلقة بالأدلة الخارجية:
أي عوامل التطور الوثائقي والتاريخي في عملية النقل النصية
- دعم الاختلاف النصي من قبل أبكر المخطوطات، أو بواسطة المخطوطات التي تحفظ بثقة النصوص الأبكر.
- دعم الاختلاف من قبل المخطوطات “الأفضل جودة”
- دعم الاختلاف من المخطوطات التي لها أوسع توزيع جغرافي
- دعم الاختلاف بواسطة واحدة أو أكثر من مجموعات المخطوطات المعترف بها من حيث القدم والشخصية وربما الموقع، أي من “أفضل نوعية” معترف بها.
- المعايير المتعلقة بالأدلة الداخلية:
أي العوامل المتعلقة بعادات الناسخ، وسياقات الفقرات، وأسلوب المؤلف ولغته وفكره
- حالة الاختلاف باعتباره أقصر من غيره أو أقصر قراءة
- حالة الاختلاف مثل أصعب من غيره أو أصعب قراءة
- ملاءمة الاختلاف لتبرير أصل أو تطور أو وجود جميع القراءات الأخرى
- مطابقة الاختلاف لأسلوب المؤلف ومفرداته
- توافق الاختلاف مع لاهوت المؤلف أو أيديولوجيته
- مطابقة الاختلاف لليونانية كوين Koine (بدلا من العلية الأتيكية Attic) اليونانية
- مطابقة الاختلاف لأشكال التعبير السامي
- عدم تطابق الاختلاف مع المقاطع الإزائية أو إلى العناصر الغريبة في سياقها بشكل عام
- عدم تطابق الاختلاف مع مقاطع اللاتينية القديمة
- عدم تطابق الاختلاف مع الأشكال والأعراف الطقوسية
- عدم تطابق الاختلاف مع الآراء المذهبية الخارجية. “إيب وفيي ص 163”
أزمة القطبية أو التعارض بين المعيير الخارجية والداخلية:
يعترف النقاد النصيون الانتقائيون بصحة جميع قوانين النقد أو معايير الأصالة التي ظهرت في تاريخ النقد النصي والتي أثبتت جدواها، كما هو في القائمة الرسمية أعلاه، بما في ذلك كلا النوعين – الخارجية والداخلية، وذلك في المواقف المناسبة ومع تساوي الأشياء الأخرى. وفقًا لذلك، سيتغلب الانتقائيون العموم على الحالة القطبية لهذه المعايير الخارجية والداخلية بتجاهل تلك القطبية أو بمحاولة تجاهلها. هذا ممكن بسهولة، على سبيل المثال، في حالة قراءة واحدة من بين عدة قراءات هي أصعب قراءة من منظور عادات النساخ، وتتفق أيضًا مع مفردات المؤلف المؤكدة وأسلوبه ومع لاهوته كما هو محدد بشكل حاسم، ويحدث في نفس الوقت أن تكون مصدقة من مخطوطات “ممتازة” ومن الترجمات القديمة أو الآباء الأوائل، ومن توزيع جغرافي واسع. في مثل هذه الحالات، حيث تكون القرارات النصية سهلة، فإن الانتقائي العام (وكل ناقد نصي آخر!) سيكون غافلاً عن كل من الإطار المزدوج لفئتين متميزتين من معايير الأصالة وأيضًا عن الغموض الذي يصاحب تطبيق تلك المعايير. ولكن، كما هو الحال في كثير من الأحيان، عندما تكون العديد من المعايير “القوية” لا تفضل قراءة واحدة ولكنها توافق بشكل مختلف على قراءة أو الأخرى، وعندما – أيضًا يحدث بشكل متكرر- يوجد تشعب في الأدلة بين الأقطاب الخارجية والداخلية، ثم يجد الناقد نفسه في معضلة لأنه يواجه “أزمة المعايير” الصعبة. إذا كانت القراءة التي تتناسب بشكل أفضل مع أسلوب المؤلف موجودة فقط في المخطوطات اللاحقة، في حين توجد القراءة المنافسة في المخطوطتين B وא (راجع متى 6: 33 [Metzger 1971: 18-19 ])، ما الذي سيتم اختياره؟ إذا صادقت B وD على واحدة من خمس قراءات مختلفة، ولكن هناك قرءتان متشابهتان أخرتان تفسران أصل كل القراءات الأخرى (راجع متى 15: 14 [Metzger: 39 ])، أي ذلك الذي سيتم اختياره؟ إذا كانت مجموعة واسعة من الأنواع النصية تشهد لصالح قراءة “أسهل” بشكل واضح من بديلها (راجع متى 15: 38 [Metzger: 40-41])، ما الذي ينبغي تفضيله؟ إذا كان هناك اختلاف قد نشأ بشكل محتمل جدا من عبارة إزائية تم حذفه من قبل “أفضل” الشهود (راجع متى 16: 2-3 [Metzger: 41])، هل يجب أن يتم قبوله في النص؟ إذا كانت قراءة أطول والتي يمكن تفسيرها بشكل شبه مؤكد كإضافة من الناسخ تحت تأثير السياق المباشر، قد تم دعمها بواسطة B وא (راجع متى 16: 21 [Metzger: 42-43])، هل يجب الموافقة عليها؟ إذا كانت الغالبية العظمى من المخطوطات، بما في ذلك المخطوطات “الأفضل”، تشهد على قراءة أقصر يمكن تفسيرها بسهولة على أنها تعديل عقائدي لقراءة أصلية أطول (راجع متى 27: 16، 17 [Metzger: 67-68])، أيهما الذي سيتم اختياره؟ إذا كان غالبية الشهود يؤيدون قراءة تبدو وكأنها أصلية على أساس الاحتمالية النسخية، لكن عددًا قليلاً من المخطوطات الأوائل و”الأفضل” لديهم قراءة أقصر (راجع أعمال الرسل 3: 6 [Metzger: 307])، أي قراءة سيتم الموافقة عليها؟
يمكن ضرب أمثلة من هذا النوع بسهولة، ولكن سيكون من الواضح أن المشكلات النصية التي تنطوي على تعارض المعايير الخارجية والداخلية شائعة. بطبيعة الحال، فإن العديد من المشكلات النصية أكثر تعقيدًا من هذه الأمثلة، لأنها قد تنطوي في الوقت نفسه، من ناحية، على أدلة خارجية مقسمة بالتساوي، ومن ناحية أخرى، عوامل داخلية متضاربة ولكنها متوازنة. هذه المواقف لا تتطلب فقط مزيدًا من الصقل في جميع المعايير وتدعو إلى إيجاد طرق لموازنتها مع بعضها البعض، ولكنها أيضًا تسلط الضوء على أوجه الغموض المزعجة التي يمكن العثور عليها في كل من الجوانب الخارجية والداخلية لمعايير النقد النصي.
مثال لصعوبة الترجيح بين النصوص حسب قوانين ومعايير النقد النصي لاختيار النص الأصح في وحدة الاختلاف
المسيح لم يقم بقوة لاهوته، تحريف يخدم عقيدة الفداء
نجد في هذا المثال تحالف (الأقدم+ الأفضل+الأكثر) يخسر المعركة
لوقا9: 22
قَائِلاً: «إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا، وَيُرْفَضُ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ»
لفظة (يقوم ἀναστῆναι) وردت في السينائية والفاتيكانية والبردية 75 وأيضاً في 85% من المخطوطات اليونانية (البيزنطية) بصيغة المبني للمعلوم (يقوم ἀναστῆναι)، لكنها وردت بصيغة المبني للمجهول في المخطوطة السكندرية وبيزا والإفرايمية بالإضافة إلى 15% من المخطوطات اليونانية (البيزنطية).
الدليل الخارجي (قيمة المخطوطات وتاريخها) في صالح قراءة السينائية وحلفاءها، فأقدم وأفضل المخطوطات تدعم قراءة (يقوم)، ولكن الدليل الداخلي يدعم قراءة (يقام) فهي القراءة الأصعب على الناسخ، فلو كانت القراءة الأصلية هي (يقوم) فما هو الدافع الذي جعل النساخ يغيرونها إلى (يقام)؟ لا يوجد مبرر قوي، لكن في المقابل لو كانت القراءة الأصلية هي (يقام) فإن النساخ سيميلون لتغييرها إلى (يقوم) حتى يبينوا أن يسوع قد غلب الموت بقوة سلطان لاهوته المحيي وقام بنفسه من الموت ولم يحتج لغيره حتى يقيمه كباقي البشر، ولهذا اختارت اللجنة النقدية الدولية قراءة (يقام) باعتبارها الأصح.
فنحن هنا لدينا إشارات تثبت خسارة قراءة السينائية وحلفائها ذوات السمعة الكبيرة:
1- الدليل الداخلي.
2-اعتماد النص البيزنطي سيئ السمعة لقراءة (يقوم) هو بمثابة إدانة لهذه القراءة.
3- نصوص الإنجيل الأخرى تدعم (يقام) المبنية للمجهول مثل: يعقوب الأولى 13: 20 (20وَإِلهُ السَّلاَمِ الَّذِي أَقَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ رَاعِيَ الْخِرَافِ الْعَظِيمَ، رَبَّنَا يَسُوعَ) وفي تيموثاوس الثانية 2: 8 (8اُذْكُرْ يَسُوعَ الْمَسِيحَ الْمُقَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ، مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ بِحَسَبِ إِنْجِيلِي،), وفي بطرس الأولى 1: 21 (21أَنْتُمُ الَّذِينَ بِهِ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ الَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَجْدًا، حَتَّى إِنَّ إِيمَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي اللهِ.), وفي أعمال 13: 30 (30وَلكِنَّ اللهَ أَقَامَهُ مِنَ الأَمْوَاتِ).
وهذا المثال يثبت:
(1) أن أفضل شواهد العهد الجديد على الإطلاق (السينائية+الفاتيكانية+البردية 75) اتفقت على نقل نص محرف!
فقد اختارت اللجنة النقدية الدولية قراءة (يقام).
(2) مهما كانت قوة الدليل الخارجي فيمكن أن يحمل بين طياته القراءة المزورة، فالأقدم ليس يقيناً هو الأصح، والمخطوط الأفضل ليس يقيناً هو الأصح، بل ولا حتى تحالف بين أقوى المخطوطات يؤدي للقراءة الأصح!! فليس لنا سوى الترجيح الاحتمالي فقط، فها هو الثالوث المرعب (السينائية +الفاتيكانية+البردية75) يخسر وخلفه 85% من المخطوطات البيزنطية!!
(3) التحريف تم من أجل دعم عقيدة الفداء وقوة المسيح.
(4) فيه دليل على أن قوانين ومنهجيات النقد النصي، بالرغم من كونها استطاعت إثبات أن النص المستلم معيب وضعيف الموثوقية، وأزاحته من تصدره وهيمنته لمدة طويلة، كما أنها أنتجت نصوصا أفضل منه، مؤسسة على أقدم وأعرق المخطوطات، إلا أن هذا العلم الجديد حتى الآن لم يبلغ الكمال والدقة المطلوبة في التمييز بين القراءات الصحيحة والمزورة، ويحتاج المزيد من التطوير.